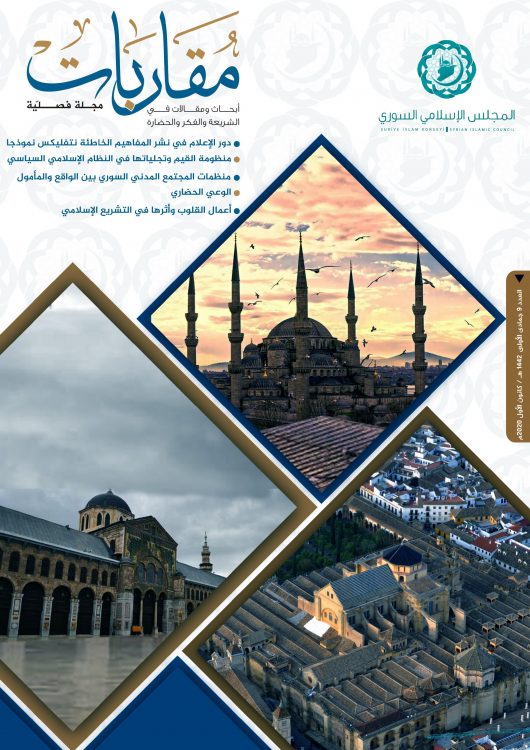رؤية تحليلية – القيم الإنسانية والسياسة بين النظرية والتطبيق على خلفية الأحداث الأمريكية والفرنسية سنة ٢٠٢٠م

المعلم بين الكتاب المنظور والكتاب المسطور
يناير 4, 2021
فلسَفةُ الأَخذِ والعَطاءِ في الإسلام .. وجهُ الإنسانيةِ المُشرِق
يناير 4, 2021رؤية تحليلية – القيم الإنسانية والسياسة بين النظرية والتطبيق على خلفية الأحداث الأمريكية والفرنسية سنة ٢٠٢٠م

تحميل البحث كملف PDF
الكاتب والإعلامي: نبيل شبيب
عناصر الموضوع: (١- مقدمة ٢- انتهاك قيم إنسانية ٣- ترامب وماكرون نموذجان ٤- التعامل مع الحدثين في الميزان ٥- وقفة فلسفية ٦- بين الحق والقوة ٧- الحصيلة)
مقدمة:
تزداد الضغوط على جنس الإنسان تحت وطأة الجناح المادي في الحضارة الغربية في عالمنا المعاصر، وتكشف الضغوط عن تناقضات صارخة، محورها الانفصام بين الطرح النظري والواقع التطبيقي في ميادين القيم والمبادئ. هذا ما استفحلت أضراره التي تصيب نسبة عالية من البشرية، داخل العالم الغربي نفسه وفي نطاق هيمنته عالميا. واستفحل أيضا تشويه مظاهر النجاح الحضاري المطّرد، علميا وتقنيا وماديا، علما بأن ما نعايشه من إنجازات في عصرنا الحاضر ليس من صنع المسار الحضاري المادي الحالي وحده، بل هو حصيلة تراكم منجزات بشرية في حلقات متعاقبة من دورة الحضارات، كان يبني اللاحق منها دوما على ما سبقه ويضيف المزيد إليه غالبا.
أما التناقض الأخطر القائم فهو تفاقم الخلل في ميادين العلاقة الفعلية بين هذه “المنجزات” وواقع “الإنسان”، وهو ما نعبر عنه غالبا بكلمة “الهوّة” الفاصلة بين ثراء وفقر، وصحة ومرض، وعلم وجهل، واستقرار وتشريد، وانتشار المظالم العشوائية بلا ملاحقة ولا محاسبة، مقابل وجود ضوابط تقنينية وقضائية بنتائج متفاوتة، وهكذا.
في سنة٢٠٢٠م كشفت انحرافات التعامل السياسي مع جائحة كوفيد-١٩ من جهة عن تغييب جوهر قيمة الإنسان حضاريا، ومن جهة أخرى عن هشاشة البنية الهيكلية للإدارة والإنتاج في الجسد المادي والتقني المعاصر. كما انكشف بالتزامن مع ذلك عمق الثغرة الفاصلة بين النظرية والتطبيق على صعيد القيم بمختلف ميادينها وتسمياتها، وهذا من خلال أحداث لا يستهان بأهميتها، تجسدت في تطورات متتابعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على وجه التخصيص.
والسؤال: هل توجد وسائل ناجعة لتضييق الفجوة، إن لم يكن ردمها، بين التنظير للقيم الإنسانية من جهة وتطبيقها من جهة أخرى، للحد من النواقص والنتوءات الظاهرة في البنية الحضارية المعاصرة، وهي قائمة على رؤى سياسية “علمانية” وممارسات “حداثية”، تضبطها أو المفروض أن تضبطها آليات دستورية ومؤسساتية “ديمقراطية”؟
هذا ما تتطلع هذه الرؤية التحليلية إلى التمهيد له بمحاولة استيعاب ماهية المشكلة التي تطرح نفسها بقوة على أرض الواقع، على أمل أن تجد محاولات للعلاج، نظريا عبر الدراسات والبحوث والمؤتمرات المتخصصة، وعمليا من خلال آليات عمل تنبثق عن خطط مدروسة وجهود منظمة هادفة.
انتهاك قيم إنسانية:
إن الحديث هنا لا يدور حول مظالم همجية من صنع الاستبداد، وُلدَت نتيجة التسلط المحلي والدولي على الشعوب وأوطانها وثرواتها، من خلال أنظمة محلية وشبكات علاقات دولية، تستهتر بكل مرجعية دستورية محلية، أو مرجعية قانونية شاملة للأسرة البشرية. إنما يدور الحديث حول الانحرافات التي أبرزتها أحداث عديدة في دول تقول إنها ديمقراطية حداثية متقدمة، وتطلق على نفسها وصف “العالم الحر”، وتعتبر نفسها الرائدة لسواها على هذه الأصعدة.
أبرز تلك الأحداث – عند كتابة هذه السطور قبيل رحيل سنة ٢٠٢٠م – ما كان من تصعيد مثير في مشهد جديد من سلسلة مشاهد مشابهة سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يركّز الطرح السياسي والإعلامي في متابعة التطورات على شخص دونالد ترامب والتعامل مع الانتخابات الرئاسية. وقد تزامن ذلك مع تصعيد مثير أيضا في فرنسا. وهنا يركز الطرح السياسي والإعلامي أيضا على شخص إيمانويل ماكرون حصرا.
من شأن هذا التركيز أن يحشر التطورات ومخاطرها في حدود “شخصنة” ما يحركها، وبالتالي ينتشر الاعتقاد أو الوهم، بأنّ الحدث سيمضي مع مضي الشخص المعني سواء كان ترامب أو ماكرون، كما يصوِّرها وضعا استثنائيا ضمن مسار ديمقراطي حداثي متوازن، أي يصور الأحداث وكأنها “انفرادية” عابرة، كما يُصنع مع ما يوصف بالقتل العشوائي الجماعي في مجتمعات “آمنة”، أي يكفي هنا أيضا أسلوب النظر في كل حالة على حدة حسب خصائصها وظروفها، دون البحث عن الأسباب العميقة في محاور ما تقوم عليه البنية الهيكلية للمجتمعات والدول الحديثة، أي البنية الحداثية الديمقراطية.
إن أحداث أمريكا وفرنسا التي يحاول الإعلام حصرها بالشخص أو تصويرها أحداثا استثنائية؛ تحتاج دراسات منهجية محكمة ومتكاملة، ولا تكفيهما مقالة رأي محدودة كهذه، وذلك باعتبار كل من أحداث أمريكا وفرنسا نموذجا عما تشهده جوانب وتطورات أخرى – ليست موضع الحديث هنا – تتعلق أيضا بالسؤال عن وسائل ناجعة تحول دون أحداث مشابهة، وبالتالي تحول دون تفاقم الأضرار وتراكمها في اتجاه قد يسبب انهيارا خطيرا للبنية الحضارية الحالية نفسها.
في هذه الرؤية يقتصر الحديث على جانب واحد، يحدّده تعبير “القيم الإنسانية” كمجموعة ما يغلب التوافق على عناوينه الكبرى، ومن ذلك التوافق على أن صون تلك القيم يمثل دعائم تحقيق إنسانية الإنسان، وبالتالي فإن تغييبها أو تغييب بعضها، لا سيما بأساليب ووسائل قهرية، يمثل انتهاكا لإنسانية الإنسان.
إن مضامين القيم الإنسانية هذه، من كرامة وعدالة ومساواة وحقوق معنوية ومادية وحريات أساسية وما يتبع ذلك، هي في مقدمة ما يجري ذكره وتأكيد احترامه على ألسنة الساسة المعاصرين بمناسبة كاليوم العالمي لحقوق الإنسان، ودون مناسبة؛ بينما لا يكاد ينقطع مسلسل الشواهد على ممارسات سياسية في واقعنا البشري المعاصر، تنطوي على انتهاك تلك القيم انتهاكا نوعيا واسع النطاق، وكميا ضخما من حيث شموله معدلات نسبية عالية من جنس الإنسان.
ترامب وماكرون نموذجان:
لم يعد خافيا ما كان من شواهد صارخة على انتهاك القيم الإنسانية والقوانين الدولية في تعامل الرئيس الأمريكي (السابق) دونالد ترامب (سنة ٢٠٢٠م ومن قبل) مع الاتفاقات ذات العلاقة بالقانون الدولي كالحد من التسلح النووي، والحد من عواقب التبدل المناخي، وتعامله مع أحداث داخلية كتغوّل أجهزة أمنية على فئات سكانية من غير ذوي البشرة البيضاء، أو تعطيل الحد من انتشار السلاح رغم ازدياد جرائم القتل العشوائي، هذا علاوة على ترسيخه للتفاوت الهائل في مستويات المعيشة بين قطاعات تعاني من الفقر والبؤس دون تأمينات اجتماعية، ومن المرض دون تأمينات صحية كافية، وبين المتخمين بالثراء الفاحش.
هذه السلسلة هي التي بلغت أقصى مداها في كارثة القصور المستهتر عن مواجهة جائحة كورونا، ثم في الإنكار المرضيّ لنتائج الانتخابات والاستماتة في توظيف الصلاحيات الرئاسية الرسمية لخدمة أغراض سياسية ذاتية قدر المستطاع، عبر أوامر تنفيذية وأجهزة أمنية ووزارات رسمية وحتى عبر أجهزة القضاء، وجميع ذلك مع هدر الأموال بلا حساب.
كذلك لم يعد خافيا ما كان من شواهد صارخة على انتهاك القيم الإنسانية والمبادئ العالمية في تعامل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قوانين تمس المناطق السكنية العشوائية على حساب حقوق سكانها، وتمس مستويات المعيشة العامة للمسنين المتقاعدين وسواهم من الفئات المهمّشة ماديا، وهو ما أثار احتجاجات متعاقبة أبرزها احتجاجات “ذوي السترات الصفراء”، ثم من خلال تصعيد الحملات المتعدية على الإسلام والوجود الإسلامي مما أثار عموم المسلمين، حتى وصلت التجاوزات الرسمية – بمشاركة ماكرون – إلى العمل على اعتقال حرية التعبير عبر تقنين حظر استخدام عدسات التصوير في مراقبة الرأي العام لممارسات عناصر الأجهزة الأمنية في الشوارع والأماكن العامة، وهي في الأصل مراقبة واجبة وضرورية لضمان مسار المحاسبة القضائية عند مخالفة القوانين، وقد تكررت باستمرار.
هذا الانحراف السياسي من جانب ماكرون وبدعمه، أثار مزيدا من الاحتجاجات الجماهيرية بل والدولية لم تقتصر على الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
إن محور الحدث في هذين النموذجين هو تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها رغم وجود الدساتير وما ينبثق عنها، وكذلك استغلال تلك الصلاحيات لتحقيق أهداف تتناقض مع روح النصوص الدستورية والقانونية إن لم تتناقض مع نصوصها مباشرة.
التعامل مع الحدثين في الميزان:
مع كل التقدير لجهود منظمات وأفراد ينشطون من داخل الغرب ويمارسون واجباتهم قدر المستطاع للحد من الانتهاكات على مستوى عالمي، وليس في نطاق الغرب فقط، نرصد أن الحدثين المذكورين أثارا الاهتمام والانزعاج أكثر من سواهما، ربما لأن انتهاك إنسانية الإنسان فيهما بلغ درجة بعيدة المدى، وربما لأنه استهدف الإنسان داخل حدود “العالم الحر” على وجه التخصيص، وهذا ما يختلف بتأثيره أو من حيث التعامل الغربي معه (وفق التكوين المعرفي التاريخي للغرب) عن حالات أخرى صارخة أيضا، ولكنها تستهدف الإنسان خارج تلك الحدود، فلا تجد الاهتمام والانزعاج والاحتجاج بحجم مماثل.
هذا ما نسميه “الكيل بمكيالين“، وهو مما يساهم في ظهور ما نرصده من ردود فعل تنطوي من جانبنا على “الكيل بمكيالين” أيضا، أي عندما تغفل انتقاداتنا واحتجاجاتنا ما تتعرض له إنسانية الإنسان عموما من انتهاكات، وتركز على ما يتعلق بالعرب والمسلمين وبالإسلام ووجوده عالميا. والواقع أن معايير الإسلام وأحكامه ورؤيته الحضارية الإنسانية تفرض الانطلاق من عمومية إنسانية الإنسان وعمومية الواجب الذاتي لإدانة انتهاكها ومكافحته حيثما يقع، وسيان من يصيب، بغض النظر عما يصنع “الآخر” في حالات مشابهة.
وإن “الكيل بمكيالين” من الطرفين يعني تجاهل المشتركات النظرية بين الرؤية الذاتية ورؤية الآخر في ميدان القيم الإنسانية، وبالتالي تغييب قابلية التواصل والتلاقي بين من يعترضون على تلك الانحرافات من داخل المجتمعات الغربية نفسها ومن خارجها.
فيما يتعلق بموضوع الحديث هنا، تنطوي حصيلة الانتقادات الذاتية المتعلقة بالنموذجين الأمريكي والفرنسي المذكورين أعلاه، على “تشخيص” وجود خلل في أنظمة أو مناهج، غربية النشأة، كالعلمانية والديمقراطية والرأسمالية، مع العلم أنها هي الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها البنية الهيكلية لدولة حداثية غربية، وإن تفاوت التأكيد والتشدد أحيانا على بعضها دون بعضها الآخر، ما بين دولة ودولة.
محور الانتقادات في هذا التشخيص هو القول إن منظومة القيم من حقوق وحريات ومبادئ، موجودة نظريا، ولكن لا تمنع في تركيب البنية الهيكلية للدولة الحداثية الغربية بالذات من وقوع انتهاكات صارخة لإنسانية الإنسان.
ونرصد بالمقابل ما يتردد داخل نطاق المجتمعات ذات الغالبية المسلمة من مواقف تتناقض مع هذه الانتقادات والاعتراضات. من الأمثلة عليها بالنسبة إلى النموذج الأمريكي، مواقف تدعي الحرص على تحقيق مصالحنا وأهدافنا لتبرير المطالبة بواقعية مزعومة، تستدعي التكيف أو حتى التبعية لما تصنع الدولة الأمريكية الكبرى عالميا، وإن انطوى على الظلم والانحراف، بذريعة أنه لا يمكن لنا دون هذا السلوك الانهزامي أن نحقق هدفا كريما.
ومن الأمثلة على تلك المواقف التعميمية بالنسبة إلى النموذج الفرنسي، المطالبة الغريبة برحيل المعترضين على السياسات الفرنسية عن فرنسا، بدلا من معارضة ممارساتها وقوانينها، وكأن المسلم الفرنسي المعارض ليس مواطنا فرنسيا!
المواقف المذكورة أمثلة محدودة على ما يصدر عموما عمّن يبالغ في الدفاع عما يتبنى الغرب نشره عالميا من مناهج تغلب عليها الصبغة “الإيديولوجية”، هذا مع إنكار المعترضين وجود تلك الصبغة أصلا في تركيبة المناهج الغربية عموما.
الواقع أن كثيرا من التصورات الاجتهادية الوضعية التي نشأت في الغرب، يحمل في صيرورته إرثا معرفيا ثقيلا من ادعاءٍ استعلائي لاحتكار الصواب. وكانت تلك التصورات الوضعية عند نشأتها الأولى في عصر التنوير ترفض هذا السلوك لاحتكار الصواب، والمتجذّر في ممارسة الإملاءات العقدية، الكنسية وغير الكنسية، في العصور الغربية الوسطى وما قبلها.
ولكن مسارات العلمانية والديمقراطية والليبرالية (الرأسمالية) شهدت لاحقا انحرافات التشدد الصادر عن توجهات حداثية ناشئة في وقت متأخر نسبيا. وهنا انفصمت صلة تلك المناهج بالفكر التنويري لحساب الفكر الحداثي، فأصبحت كأنها وليدة فكر “إيديولوجي” متعصب، بغض النظر عن استمرار رفض الإيديولوجيات “الأخرى”.
المفروض هو عدم التردد في وصم سياسات التعصب والتحجر والانحراف بما هي جديرة به، سواء كانت غربية أم لم تكن، وبدلا من ذلك تتركز مواقف أبناء أمتنا على محورين اثنين خاطئين هما:
(١) ضرورة تخلصنا نحن من الإيديولوجية في فكرنا وسلوكنا، وغالبا ما يكون المقصود هو عدم الانطلاق من الوحي الرباني مصدرا للعقيدة والفكر والتوجيه.
(٢) مقولة إن نهوضنا لا يتحقق دون تحقيق شرط الحداثة كما عرفتها أوروبا، وغالبا ما يكون المقصود هو الحداثة الإلحادية.
وقفة فلسفية:
إن استحضار ما ينبني على ذلك ضروري لتحديد الموقف الأصوب من أحداث أمريكية وفرنسية، مع إدراك أنه موقف من واقع معاصر لدول “حداثية”.
لهذا تتطلب متابعة الحديث وقفة فكرية فلسفية عند العلاقة بين محطات التنوير والحداثة والإلحاد ومسارات النهوض. هذا مع الحفاظ على جوهر البحث في هذه الرؤية التحليلية، إذ يدور حول العلاقة بين أطروحات سياسية نظرية، تعتبر البنية الحداثية الديمقراطية الراهنة وضعا مثاليا، معبرا عن منظومة القيم من حقوق وحريات، وما يعنيه ذلك تجاه افتقار تطبيق تلك المنظومة إلى تحقيق ما تقتضيه إنسانية الإنسان دون تمييز أو استثناء.
واستحضار ما سبق ذكره حول القيم الإنسانية والإلحاد الحداثي، ضروري أيضا على خلفية إعداد هذه الرؤية للنشر في مجلة “مقاربات” الصادرة عن جهة إسلامية معتبرة هي المجلس الإسلامي السوري. هنا يحسن التنويه إلى أن المقارنة في إطار عناوين القيم الإنسانية الكبرى، كالكرامة والعدالة والمساواة، تكشف عن وجود مشتركات نظرية عديدة، ما بين منظومة القيم المستمدة من الوحي الرباني أو الاجتهاد المبني عليه، وبين ما يقابلها من مبادئ ومُثُل وجدت طريقها إلى مواثيق وضعية، توصف بالحداثية أحيانا.
هذا التنويه لا ينفي وجود اختلافات يصنعها فارق الانطلاق من الإيمان بالوحي عن الانطلاق من إنكاره. إنما لا داعي هنا للتوسع في تعليل الاختلافات بحقيقة تباين المنطلق العقدي والفكري، وبالتالي بموقع العاقبة الأخروية بين إيمان وإنكار، وتأثير ذلك على ما نعرفه تحت عنوان “الوازع الداخلي”، كما هو الحال مع سائر الغيبيات.
الفلسفة بحد ذاتها علم من العلوم الإنسانية له ضوابطه المحكمة، ولكن الحديث يدور هنا حول تصورات وتوجهات فلسفية، أصاب بعضها وأخطأ بعضها أو انحرف، ومن ذلك ما ساهم في تبرير انتهاك إنسانية الإنسان.
المنطلق الفلسفي ضروري لاستيعاب ما يجري في دولة حداثية غربية حاليا، والحد الأدنى من ذلك أن نميز بين كلمتي “التنوير” و”الحداثة” في المسارات الفلسفية الغربية من جهة، وأن نميز من جهة أخرى غياب الدقة العلمية فيما ينقل من أطروحات فلسفية غربية إلى مجتمعات مرتبطة تاريخيا بالدائرة الحضارية العربية الإسلامية، لا سيما مجتمعات المنطقة العربية، ومن ذلك ما يتعلق بالفلسفة الحداثية وما واكبها من إلحاد، والقول إن ذلك كان مفتاح النهضة الأوروبية، وبالتالي ينبغي سلوك طريق مماثل لنحقق نهوضنا. هذا غير صحيح تاريخيا.
(١) إذا كان الإلحاد موجودا منذ العصور القديمة بمعنى إنكار وجود إله خالق للكون، فمن المؤكد أن ربطه بفلسفة حداثية معاصرة قد جاء متأخرا. ولا مجال للترويج أن النهوض العلمي المادي منذ زهاء أربعة قرون قد ارتبط بتبني فلسفات إلحادية، فقد ظهرت قبل قرنين أو أقل، مثل الوجودية التي أسس لها سورين كيركغور الدانماركي في القرن الميلادي التاسع عشر، وطوّرها وزاد عليها جان بول سارتر في القرن الميلادي العشرين، ومثل المادية الجدلية والحتمية التاريخية مما طرحه هيجل وطوره ماركس من بعد عبر القرن الميلادي العشرين أيضا، وجميع ذلك وأشباهه كان بعد أن وقفت النهضة المادية الحديثة في أوروبا على أقدامها.
(٢) بالمقابل ظهرت مع بداية النهضة الأوروبية مسارات فلسفية طرحت على صعيد الإنسان والعقل والمعرفة والحقوق والحريات ما لا يبتعد كثيرا عما يطرحه الوحي.
(٣) من ذلك أطروحات الفلسفة الإنسانية في القرن الميلادي الرابع عشر، ولم تعرف “الإلحاد” الحداثي، وكان منطلقها الجغرافي إيطاليا، ومحورها الموضوعي تحرير التعليم من احتكار “السلطة الكنسية” له تحت عنوان “العلوم السبعة”.
(٤) ومن ذلك أطروحات فلسفة التنوير في القرن الميلادي الثامن عشر (أشهرها: المعرفة / إيمانويل كانط الألماني، والحرية / فرنسوا فولتير الفرنسي، والعقد الاجتماعي / جان جاك روسو الفرنسي أيضا) ولم تطرح الإلحاد الحداثي.
(٥) واقترن ذلك ببدايات مسيرة النهضة العلمية التقنية باختراعات واكتشافات في فترة مبكرة نسبيا، ويرى بعض المؤرخين بدايتها عام ١٦٨٧م (كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية لإسحق نيوتن) ومنهم من يعود ببدايتها إلى عام ١٤٥٣م، عام “سقوط” القسطنطينية -إسطنبول حاليا-، ومن محطاتها اكتشاف الجاذبية واختراع الطباعة واكتشافات فلكية خالفت ما كانت تشمله الإملاءات الكنسية.
(٦) ما يسري على الإلحاد الحداثي وعدم إسهامه في “النهوض” يسري على ما يوصف بالبراجماتية، وهنا لا تصح الترجمة الشائعة: “الواقعية”؛ فهي تختلف عن مقتضيات الفلسفة الواقعية المجردة، بأنها فلسفة “نفعية أنانية”، ويقول معجم “أوكسفورد” في تعريفها، إنها تضع السلوك فوق مراعاة العقل، أو القانون، أو الحقائق، أو الأفكار والنظريات سارية المفعول، التي تقاس قيمتها فقط بمعيار تحقيق النجاح. وقد نشأت هذه الفلسفة في أمريكا الشمالية أواخر القرن الميلادي التاسع عشر، وكان من أبرز الفلاسفة المنظرين لها تشارلس ساندرس بييرس وويليام جيمس. ويمكن اعتبار السياسات الأمريكية منذ ذلك الحين تطبيقا مباشرا لها.
إن الانحرافات الحداثية عن أطروحات فلسفة التنوير، هي التي جعلت فيلسوف “ما بعد الحداثة” الفرنسي ميشيل فوكو يطلق مقولته الشهيرة “إن الأنوار التي خلقت الحريات هي التي خلقت السلاسل والأغلال أيضا”، وكلمة الأنوار عنده تعني فلسفة التنوير وتشمل انحرافها لاحقا عبر فلاسفة الحداثة بعد حوالي قرنين من نشأتها الأولى، فليست “دعاوى الحداثة” جديرة بالإشادة كما يصنع بعض الفلاسفة العرب المحدثين، ومثال ذلك ما ينقله الكاتب السوري فواز حداد في مقالة له في “العربي الجديد” يوم ٤ / ٨ / ٢٠٢٠م بقوله: (دعاوى الحداثة كانت صدى لطروحات المفكرين والفلاسفة، أحبطها انتشار آليات التدجين والمراقبة السلطوية).
بين الحق والقوة:
ليست “الفكرة” هي التي تمارس “انتهاكا” لإنسانية الإنسان وإنما هو السلوك العملي، ومن أشكاله التعصب وزعم احتكار الصواب، وهذا أقرب تفسير لكلمة “إيديولوجيا” فلا يصح ربط الكلمة بالتعصب للعقيدة فحسب، والأهم من ذلك سلوكيا هو اعتماد القوة وسيلة لتحقيق أهداف نفعية أنانية على حساب “الآخر”، وإن كانت حقوق “الآخر” معروفة وظاهرة للعيان.
هنا نتجاوز الأرضية الفكرية التأصيلية لمعالجة انتهاك إنسانية الإنسان في الحدثين النموذجين الوارد ذكرهما آنفا، وننتقل إلى انتقادات واعتراضات تناولت “أعراض” المشكلة. وسرعان ما يبدو للوهلة الأولى وجود حجة منطقية عند من ينوه بمفعول دولة المؤسسات في تصحيح الأخطاء والانحرافات، وهي كفيلة بهذا المنظور أن تضع حدا لمن يتجاوز حدوده، مثل ترامب وماكرون.
هذه مقولة سليمة نظريا، ولكن لا تسري على المثالين المذكورين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فليست الانحرافات هنا “فردية” لتقوّمها المؤسسات، بل هي انحرافات مؤسسات، فكل من ترامب وماكرون يمثل في نظام بلده الرئاسي الديمقراطي مؤسسة السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة النطاق دستوريا.
كذلك قد نجد حجة منطقية للوهلة الأولى في القول إن الدورات الانتخابية كفيلة بالتخلص السلمي الضروري من الانحرافات. وهذه مقولة صائبة أيضا من حيث الأساس، ولكنها لا تعالج الإشكالية إلا جزئيا، فمع كل الحرص على أهمية اتباع الأسلوب السلمي في تداول السلطة، يظهر للعيان في المثالين المذكورين أن من يريد البقاء في السلطة هو الذي يوظفها – وهي سبب أساسي من أسباب القوة – فيمارس العنف “السياسي” بأشد صوره ضد من يبدو له أنه عقبة في طريقه.
إن محور إشكالية القيم الإنسانية وموقعها سياسيا، في الحدثين الأمريكي والفرنسي، هو تغليب مفعول القوة على مفهوم الحق ومغزاه بمختلف المعايير. فالمؤسسة الرئاسية في كل من البلدين تتصرف بقوة الصلاحيات السياسية التي حصلت عليها دستوريا كسلطة تنفيذية، وتضع في حساباتها أن يقع انتهاك إنسانية الإنسان، وهذا عن علم بذلك، انطلاقا مما يقال رسميا عن مكانة حقوق الإنسان وحرياته.
وتتضح معالم المعضلة بالرجوع إلى جذور نشأة منظومة القيم الإنسانية في الغرب عموما، فهي حسب مؤرخيه وليدة أتون الصراع عبر حرب الاستقلال الأمريكية وأتون الصراع عبر الثورة الفرنسية، أي كانت القيم نفسها حصيلة استخدام القوة. لهذا أصبحت الممارسات التطبيقية أيضا تدور حول مقولة: (الحقوق والحريات تنتزع انتزاعا)؛ أي لا بد من استخدام القوة لتحصيلها، وهنا يرتبط تحصيل الحقوق بأن تمتلك الفئات الأضعف اجتماعيا وسياسيا كالعمال والنساء والفقراء والمسنين أسباب القوة اللازمة لخوض جولات الصراع مع من يملك زمام تحويل “حقوقهم” من الكلام عنها إلى واقع يعيشونه.
هذا خلل في التفكير والتطبيق، فعلى أرض الواقع نجد أن المحروم من حقوقه محروم أيضا من أسباب القوة لتحصيلها. بل نعايش نتائج هذا الخلل في واقع عدم تحقيق أهداف أساسية على مدى قرنين وأكثر من خلال حركات “تحرير” المرأة، بل ظهرت العواقب في نتائج عكسية، وشبيه ذلك ما نستخلصه من جولات أجور العمال وشروط العمل، وظهور نتائج عكسية منها أيضا، من معالمها استمرار تفاقم هوة الفقر والثراء داخل المجتمعات الغربية المعنية.
الحصيلة:
الحصيلة بإيجاز:
لا يمكن أن يكون للحديث عن القيم الإنسانية مفعول تطبيقي في واقع حياة الإنسان ومعاملاته دون تحقيق شروط أساسية محورا لبنية سياسية ودستورية قويمة، ونجد فيما قرره الوحي في الدين الإسلامي ما يكفي من المنطلقات لصياغة تلك الشروط، ومنها ما يوصف بالثوابت، ومنها ما يحتاج استخلاصه إلى اجتهادات تشريعية وفقهية، متجددة، لبلورة منظومة قابلة للتطبيق والمراجعة والتطوير باستمرار بما يواكب سرعة تقلب المعطيات والمتغيرات في عصرنا الحاضر.
ومن الأمثلة على الشروط المشار إليها:
١- تشكيل الأسس المعتمدة في أي دولة، لا سيما النصوص الدستورية وما يسمى “العقد الاجتماعي”، على قاعدة أن الحقوق الفردية واجبات مجتمعية جماعية، فلا يكفي أن يخاطب المحروم منها لإنهاء حرمانه بنفسه، بل ينبغي للدستور والقانون أن يوجب على المجتمع وأن يفرض على سلطات الدولة مالكة القوة، ممارسة العمل القضائي والتشريعي والتنفيذي، لإزالة الحرمان ومنع الانتهاكات.
وهذا بالمنظور الإسلامي من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن قبيل فروض الكفاية.
٢- إن كلمات النصوص ذات العلاقة بالقيم الإنسانية لا تحولها إلى معايير معتمدة في الحياة العملية، ولا تعطيها قوة ذاتية بحيث تدفع الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام بها في المسارات السياسية وسواها، ما لم تتحقق فيها “صناعة الإنسان”، فلا بد أن تقترن النصوص بمناهج ومشاريع تأهيلية للفرد وتنموية للمجتمع، وملزمة لكل من يعمل في تكوين المواصفات الشخصية للفرد، بدءا بدور التربية والتعليم، مرورا بمراكز البحث والتنمية والتأهيل والتطوير، انتهاء بصياغة المشاريع في نطاق مسؤولية الدولة بسُلُطاتها المختلفة عن المجتمع وأفراده.
وهذا بالمنظور الإسلامي من قبيل ربط أداء الواجب وتجنب التعدي على الآخر بتكوين الوازع الداخلي فرديا واعتباره جزءا من صياغة التشريعات التقنينية وتطبيقها على مستوى المجتمع.
وزيادة التفصيل في هذا تحتاج إلى طرح فكري وفقهي تأصيلي في دراسات محكمة وبحوث منهجية مع التخطيط لها عبر مراكز البحوث والدراسات، ومواكبتها بسلسلة من المؤتمرات الهادفة، كما هو الحال مع الحاجة إلى شبيه ذلك في متابعة سائر القضايا الأساسية المعاصرة، المشابهة للقضية التي تطرحها هذه الرؤية التحليلية الموجزة حول الجمع بين النظرية والتطبيق في الحفاظ على إنسانية الإنسان وما ينبثق عنها من قيم وحقوق وحريات وواجبات ومسؤوليات.
ولله الحمد من قبل ومن بعد.