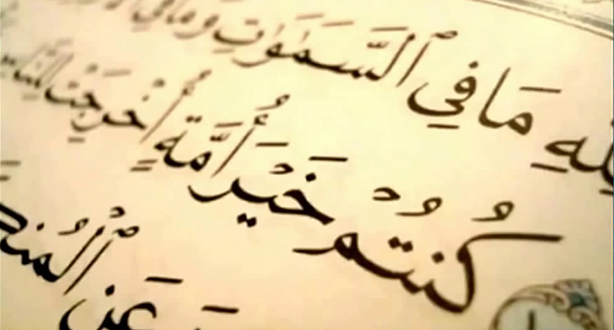خطوط عريضة في نظام الحكم في الإسلام (1)
أكتوبر 18, 2016كي نستفيد من القرآن
أكتوبر 24, 2016خطوط عريضة في نظام الحكم في الإسلام(2)
الكاتب: الدكتور عبد الكريم بكار – عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري
4- إجمال المتغير:
خلود رسالة الإسلام اقتضت شيئاً مهماً نلحظه بوضوح في منهجية التشريع، وهو أن ما يتغير بتغير الزمان والمكان جاء في الشريعة الغراء مجملاً، فيه نصوص هادية وخطوط عريضة، وما لا يتغير بتغير الزمان والمكان جاء في الشريعة مفصلاً غاية التفصيل، وعلى سبيل المثال: فإن ما يتعلق بأصول الاعتقاد، وما يتعلق بالعبادات وبالطبيعة البشرية والعلاقة بين الجنسين، جاء في الشريعة مفصلاً، فمهما تغيرت الحالة الحضارية للشعوب المسلمة، ومهما تباعدت أمكنتهم، فلن يجدوا احتياجاً إلى أن يصلّوا الظهر خمس ركعات، أو يصوموا من الظهر إلى المغرب عوضاً عن الصيام من الفجر إلى المغرب، ولن يجدوا أنفسهم مضطرين لأن تكون المرأة هي من يخطب الرجل، أو تكون هي من يدفع المهر، أو يملك حق الطلاق … هذه الأمور المعزولة عن تأثير الزمان والمكان تكون النصوص فيها غزيرة مما يضيّق دائرة الاجتهاد فيها، ويجعله عبارة عن تنويع على الإجماع أو القدر الكبير من المتفق عليه، أي أن الخلاف فيها يكون في الجزئيات، وهذا واضح جداً في أركان الإسلام العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. على حين أن أوضاعاً وشؤوناً من نحو الشورى وتنظيم المعارضة وانتقال السلطة وشكل الحكومة والعلاقات الدولية وهيكلة القضاء وإدارة الشؤون الصناعية والاقتصادية وما شاكل ذلك … إن كل هذا يتغير بتغير الزمان والمكان، ولهذا ففيه توجيهات هادية والقليل القليل من النصوص التي تتحدث عن الاتجاه العام والخطوط العريضة، وقد ألمحت إلى أن دائرة الاجتهاد في الإسلام تضيق حين تكثر النصوص، وتتسع حين تقل النصوص، وهذا في الحقيقة من عظمة هذا الدين وكماله.
والشريعة في بعض الأحيان تصمت صمتاً تاماً تجاه بعض الأمور المتغيرة، فلا تسن أي تشريع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة الكاملة لعقولنا كي تجتهد وتُبدع وتبتكر، وقد ورد ما يدل على أن ذلك من رحمة الله بعباده حيث روي عنه أنه قال: “إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها ” حديث حسن رواه الدار قطني وغيره.
إن الكون في اتساع، ونظم الحياة أيضاً تمضي نحو الاتساع والتعقيد، وهذا يعني أن ما لدينا من رؤى ونظم ومعالجات إدارية وإصلاحية يتقادم مع الزمن، ويحتاج إلى تجديد وتحوير، وأحياناً يحتاج إلى نسخ وتبديل، ومن هنا كانت لدينا القاعدة المنهجية العظيمة: “لا تتسع مرحلة سابقة لمرحلة لاحقة” .
إن التقدم الحضاري والاتساع العمراني الذي شهده عصر التابعين، جعل ما ورثوه من فتاوى واجتهادات ونظم من عصر الصحابة رضوان الله عليهم غير قادر على توفير الغطاء الثقافي لعصرهم، فما كان منهم إلا أن اجتهدوا واقتبسوا من الأمم الأخرى، وهذا ما فعله المسلمون في كل العصور التالية، وهذا ما علينا فعله اليوم على العديد من الصعد.
حين تكون النصوص قليلة في قضية أو مجال ما، وتكون الاجتهادات كثيرة، فإن هذا يعني أننا سنحصل على كثير من الآراء الظنية، وسنشعر أننا نقف على أرض هشة، وهذا يتطلب منا عدداً من الأمور:
منها: أن نبحث الخلاف بروح متسامحة وعلى اعتقاد أن الصواب قد يكون مع المخالف على ما أصَّله الإمام الكبير (الشافعي) حين قال: “مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب”.
ومنها أيضاً: أن نعبر عن آرائنا بصيغة تفيد الترجيح والاجتهاد بعيداً عن القطع والجزم، ومن روائع الإمام الجويني في كتابه (الغياثي) أنه عتب على الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) بأنه ساق الظنيات مساق القطعيات، إنه يقول: “إن مسائل الحكم والنظم السياسية، وما يتعلق بها من فقه السياسية الشرعية، هي أمور مبنية على الاجتهاد بسبب قلة النصوص، وهذا يستوجب صياغة الرأي فيها على نحو يوحي بذلك، ولم يفعل المارودي ذلك كما يلمسه كل من ينظر في كتابه “.
5- قصور فقهنا السياسي:
كل العلوم وكل الحالات والمسائل التي يكون الإنسان طرفاً فيها تجنح إلى التعقيد والغموض، ويكون التعامل معها صعباً، وكلما كان وجود الإنسان أشد كثافة في قضية من القضايا كان التعامل معها أصعب، هذه سنة ربانية ماضية في الحياة وفي جميع شؤون الإنسان، ولا يخفى أن عمل الدول والحكومات هو إدارة شاملة للشأن الشعبي العام، ولهذا فإن نضوج الفقه المتعلق به يحتاج إلى وقت وجهد أكبر بكثير مما يحتاجه الفقه المتعلق بالفرد المسلم، وترى هذا واضحاً في (الفروض العينية) إذ إن ما كتب فيها غزير جداً وواضح وناضج إلى حد الاحتراق على حين أن الغموض والتعقيد يلفّان (الفروض الكفائية) وما ذلك إلا لأن مناط الفروض العينية هو الفرد على حين أن المجتمع هو مناط الفروض الكفائية.
إن أمتنا الإسلامية مرت بمرحلة طويلة جداً من الانحطاط الحضاري والجمود العمراني، وتلك المرحلة استمرت عدداً من القرون، وإن من المألوف في مرحلة كهذه تقديس أقوال الآباء والأجداد وتحويل الكثير من الاجتهادات التي تمت في إطار الوحي -على نحو عام– إلى شيء له مصدرية الوحي وعصمته، على حين أن المطلوب من العقل المسلم أن يظل في حركة ترددية بين الوحي بوصفه مصدراً للتشريع والتقنين وبين الواقع الذي ستنزل عليه الأحكام وثمرات الاجتهاد.
إن العالم المسلم المتخصص والمتمكن من علوم الشريعة مطالب بالاجتهاد في شؤون زمانه كما كان أسلافه من أهل العلم مطالبين بالاجتهاد في شؤون زمانهم، لكن الانحطاط الحضاري يفسد كل شيء، ومن الواضح في هذا السياق أن حركة العقل هي انعكاس لحركة اليد، فحين تكون الحياة العامة موّارة بالتغير والتطور، فإنها تحث العقل على الاجتهاد وتوليد الأحكام التي توفر الغطاء الفقهي وتوفر الفتوى لمعالجة الأوضاع الجديدة.
إن العلوم الاجتماعية والإنسانية هي ثمار الواقع المعيش، فحين يكون في حالة تغير وتطور يفرز الكثير الكثير من الظواهر التي تتطلب من العقل التفاعل معها والتنظير لها، ولك أن تلمس هذا واضحاً في حال علوم الاقتصاد الإسلامي خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث إن انتشار البنوك الربوية والبنوك الإسلامية وتزايد أعداد الناس الذين يرغبون في توسيع تجاراتهم وأنشطتهم المالية دعا إلى وجود العشرات من أقسام الاقتصاد في الجامعات الإسلامية وغير الإسلامية، كما دعا إلى تشكيل عشرات لجان الفتوى المتخصصة بالشأن الاقتصادي والمالي تحديداً، ودعا كذلك إلى عقد مئات المؤتمرات والندوات التي تساعد على بلورة فقه اقتصادي مؤطر بالشريعة الغراء ونابع منها، ولم تكن الحال كذلك في المجال السياسي لأن واقع الحكومات والنظم السياسية في العالم الإسلامي ظل أقرب إلى الجمود منه إلى الحركة. إن الفقه السياسي أو ما يُعرف بـ(السياسة الشرعية) ظل على امتداد التاريخ الإسلامي المدماك الأضعف في صرحنا الفقهي الشامخ، وهذا لا يعود إلى جمود الواقع المعيشي فحسب، وإنما ظل كذلك لأن تطويره كان كثيراً ما يصطدم برغبات وأوضاع السلطة الزمنية المهيمنة على الفضاء العام، ومنه المجال العلمي والاجتهادي على حين أن الفقه المتعلق بالعبادات مثلاً كان طليقاً وحراً إلى حد بعيد. أضف إلى هذا أن التاريخ الإسلامي كان في كثير من مراحله زاخراً بالحروب والقلاقل والصراعات والفتن، وذلك للعديد من الأسباب، وهذا أثار مخاوف الفقهاء من الوقوع في الفتن، وانشطار الدول والمجتمعات، مما جعلهم ينظِّرون لاجتماع الكلمة والتخويف من الفرقة، وفي هذا الإطار تم منح الشرعية لولاية (المتغلب) لكن هذا كان في الحقيقة على حساب تطوير الأساس النظري للنظام السياسي الإسلامي وعلى حساب نقد الإخفاقات السياسية الهائلة التي عانى منها المسلمون في وقت مبكر جداً من تاريخ حضارتنا الزاهية.
الفقه السياسي الإسلامي يحتاج إلى تجديد مستمر لعدد وافر من الاعتبارات والحيثيات منها:
أ- خلود الشريعة الغراء اقتضى أن يكون في إدارة الشأن الإنساني العام الكثير من الفراغات التي يتوجب على أهل كل زمان أن يملؤوها بما يتناسب مع أحوال زمانهم ومتطلباته، عبر عمليات اجتهادية متتابعة، ولهذا فإنك لا تجد في الكتاب والسُّنة نصوصاً صريحة في دلالتها على كون الشورى ملزمة أو مُعْلمة وعلى كيفية تنظيم المعارضة وعلى جواز أو منع إقامة الأحزاب السياسية، كما أننا لا نجد نصوصاً صريحة تفصِّل مواصفات الإمام أو أهل الحل والعقد أو تفصِّل في آليات انتقال السلطة … هذا كله يعني أنه ليس في الأمور المشار إليها محددات وتفصيلات، تصلح لكل الأقوام وكل العصور والأزمان، ومن ثم يصبح الاجتهاد في توفيرها واجباً على علماء كل زمان لأن عدم توفيرها يفوِّت الكثير من المصالح، ويؤدي إلى الكثير من النزاعات والفتن الهوجاء، وإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب- الأعمال التي يقوم بها الإنسان تنقسم إلى قسمين: عبادات وعادات.
العبادات: هي أعمال يقوم بها الإنسان بغية التقرب إلى الله تعالى، وبغية إبراء ذمته مما هي مشغولة به، وهذه توقيفية، وتحتاج إلى دليل لأنه لا يُتقرب إلى الله تعالى بغير ما يحب.
أما العادات: هي الأعمال التي يقوم بها الإنسان من أجل قضاء حاجاته وتحقيق رغباته ومصالحه واستمرار وجوده، وذلك مثل الأكل والشرب والبيع والشراء والزراعة والصناعة والسفر … هذه الأعمال، الأصل فيها الإباحة فيباشر المسلم منها ما يحتاج إليه ما لم يكن هناك نص على المنع أو التحريم، وإن تحريم الحلال يماثل تحليل الحرام في مخالفة أمر الله تعالى وقد قال سبحانه: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى: 21 ، وقال سبحانه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) يونس: 59 .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله: “وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله “. هذا كله يعني أن حرية الحركة تنظيراً وتقعيداً وتنظيماً فيما هو من قبيل العادات هي الأصل، ولا شك في أن مسائل الحكم هي من قبيل العادات وليست من قبيل العبادات، وهذا لا ينفي أن يُتقرب ببعض العادات والمباحات إلى الله تعالى حين تكون وسيلة لعبادة كما هي الحال في النوم المبكر على نية الاستيقاظ لقيام الليل.
ج- كان التنظير الفقهي للنظام السياسي الإسلامي في القرون الأولى قائماً على أساس وجود دولة فتوحات ليس لها حدود ثابتة، وهذا يتطلب نظاماً سياسياً يختلف عن النظام السياسي المطلوب اليوم، حيث الدولة القطرية محدودة الأبعاد بدقة. في الدولة )الإمبراطورية( يكون هاجس التمزق إلى دويلات مُهيمناً على كل مفاصل النظام، ولهذا فإنه يتم الجنوح إلى تركيز السلطة في شخص الخليفة أو الرئيس، أما اليوم فإن توزيع السلطات هو ما تفضله نظم الدولة القطرية بغية الحد من تغول الدولة وتمددها، وهذا باعث آخر على تجديد الفقه السياسي ونقده بما يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الغراء على أفضل وجه ممكن.
د- السياسة هي فن الممكن، وهي فن إدارة الشأن العام، وهي فن الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهي أيضاً فن تكثير الأصدقاء وتقليل الأعداء وهذا على مستوى العالم، وليس على مستوى دولة من الدول أو ملة من الملل. ومن هنا فإن لدى العالم اليوم خبرات سياسية كثيفة وراقية في الشفافية وتحقيق الشورى ومكافحة الفساد واستغلال السلطة وتنظيم المعارضة … ولا بد لأمتنا أن تستفيد من تلك الخبرة في تطوير حياتها السياسية عن طريق الاجتهاد والاقتباس في إطار المبادئ الكلية والنصوص الصريحة والثابتة الواردة في الشأن السياسي، وعلى سبيل المثال فإن الخبرة القديمة التي توفرت لدى فقهائنا القدامى كانت تجنح إلى التركيز على صفات ومؤهلات من يصلح للخلافة أو الإمامة العظمى، وقد تبين فيما بعد أن فائدة ذلك التركيز كانت محدودة، لأن معظم الصفات كان نسبياً وغامضاً على حين أن الخبرة التنظيمية المتوفرة اليوم تجنح إلى تجويد )النظام السياسي( الذي تخضع له الحكومة والشعب معاً، فالنظام السياسي المحكَم والمتطور هو الذي يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق للسلطة، وللشعب، وهو الذي يتيح التخلص من الحكومة السيئة أو العاجزة من غير إراقة دماء. في ختام هذه الفقرة أودّ التأكيد على ضرورة أن يكون الاجتهاد في تطوير نظامنا السياسي جماعياً ومؤسساتيَّاً، فهو أجدر بثقة الناس وأجدر بالوصول إلى الحق.
6- أزمة بدائل:
حين قامت ثورات الربيع العربي شعر كثيرون بوجود أزمة كبرى على الصعيد السياسي، وذلك بسبب وجود انقسام مجتمعي كبير حيال النظام السياسي الذي يجب ترسيخ أركانه، وبما أن مجتمعاتنا مسلمة، فإن فكرة تأسيس خلافة أو إمارة إسلامية فكرة جذابة لكثير من الشباب المسلم، والحقيقة أن حقبة الخلفاء الراشدين تتمتع بوهج كبير رغم مرور القرون. لكن الزمان قد تغير وحجم الدول صار كبيراً جدَّاً، وإذا قسنا )الدولة( على )الشركة( فإن ما تتطلبه إدارة شركة فيها أربعة ملايين عامل مثل (تويوتا) يختلف كثيراً عما تتطلبه إدارة ورشة فيها خمسة عمال، أضف إلى هذا أن الثقافة التي يحملها أبناء الشعوب الإسلامية ليست ثقافة إسلامية نقية، فهناك من هم منجذبون إلى الفكر والتاريخ الإسلامي، وهناك من هم مفتونون بالتجربة الغربية في الحكم والتي تقوم على الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية، وهناك من لديهم ميول يسارية، وهناك أشخاص كثيرون لا يعرفون أي شيء عن كل ما ذكرناه، ولا يعرفون ماذا يريدون!.
الديمقراطية أثبتت قدراً لا يستهان به من النجاح والاستمرار وتوفير الاستقرار لكثير من شعوب الأرض، لكن النظام الديمقراطي يمنح الناس حق التشريع وتحريم الحلال وتحليل الحرام، ونحن نعتقد أن السيادة للشريعة، وأنه ليس من حق أي برلمان أو أي حكومة تشريع ما يخالف معتقدات المسلمين أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة لديهم، كما أن للديمقراطية العديد من العيوب، فهي تقوم على تحكيم صناديق الاقتراع مع أن التجربة الإنسانية تقول: إن من غير العدل التسوية بين العالم الخبير والسياسي البارع في اختيار الرئيس أو البرلمان وبين الأميّ والجاهل والأخرق الذي لا يحسن اختيار أي شيء، كما أن الديمقراطية لا يستقيم أمرها إلا من خلال تشكيل أحزاب سياسية تقوم بنشر الوعي السياسي، وتعريف الناس بواجباتهم وحقوقهم، لكن الذي ثبت أيضاً أن تحزيب المجتمعات قد أدى إلى تفتتها وإثارة الشحناء والبغضاء في العديد من مفاصل حياتها إلخ …
إذن يمكن القول: إننا نعاني من أزمة حقيقية على صعيد اختيار نوعية النظام السياسي الذي يُلبي حاجات المسلم المعاصر على صعيد الحرية والكرامة والعدالة والأمن والازدهار والنزاهة والاستقرار مع الانسجام مع عقيدته والمبادئ الكبرى التي يؤمن بها، إن كل ما أنتجه الإنسان من نظم على كل الأصعدة الحياتية، مصاب بالقصور الذاتي، ويحتاج إلى التطوير المستمر.
من السهل دائماً أن ننقد هذا النظام السياسي أو ذاك لكن من العسير دائماً أن ننتج نظاماً يبرأ من العيوب التي لاحظناها على النظم الأخرى، ولهذا فلا بد من القبول بنظم منقوصة، ثم يكون بذل الجهد في إصلاحها وترشيدها. وعلى كل حال فإن التجربة العالمية تقول: إن كل دول العالم وشعوبها خاضت صراعات مريرة على طريق تنازع السلطة وتوزيع القوة، وإن الإخفاقات في ذلك أكثر من النجاحات، ولا يمكن لنا أن نكون استثناء من العالم، المهم أن نحدد ما نريده من النظام السياسي، وما الذي نحذره، ثم نمضي في طريق الإصلاح السياسي والاجتماعي وفق ذلك التحديد.
إن طريق تطوير النظم السياسية والاجتماعية طريق طويل جدّاً يستغرق عقوداً كثيرة، والانتكاس فيه غير مستبعَد، ولكن مما يسهِّل العمل أن معالجة شؤون الحكم والسلطة هي شأن عالمي مملوء بالتجارب والخبرات والنجاحات والإخفاقات، وعلينا الاستفادة من كل ذلك بغية بلورة نموذج سياسي إسلامي ينسجم مع رؤيتنا للحياة، ويحقق طموحات المسلم المعاصر، ويلبي احتياجاته الروحية والمادية، وهذا مع صعوبته يظل في حيِّز الممكن.