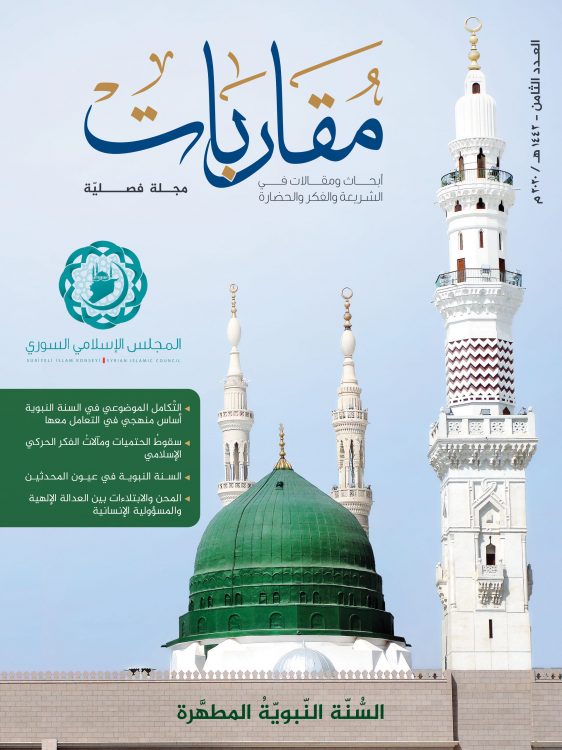المعيار الشرعي لطلب الشهادة
سبتمبر 14, 2020
المحن والابتلاءات بين العدالة الإلهية والمسؤولية الإنسانية
سبتمبر 14, 2020سقوطُ الحتميات ومآلاتُ الفكر الحركي الإسلامي

تحميل البحث كملف PDF
د. حسين عبد الهادي آل بكر
التنوع الحضاري نتيجة حتمية للتنوع الثقافي، فالثقافة هي المشكِّل الأساس للحضارة، ومنها ينبثق الأداء الأخلاقي الحضاري، فكلما كان الأداء الأخلاقي إيجابيًّا منسجمًا مع كرامة الإنسان وأمنه متسقًا مع العدل والسلام كانت الحضارة آمنةً مستقرةً مطردةً في الارتقاء.
في سياق حديثنا عن الحضارة يمكن القول بأنها تقوم على عاملين اثنين؛ أولهما عامل مادي، وثانيهما عامل أخلاقي سلوكي قيمي، فالحضارة تعني مجموع مدنية كل أمة وثقافتها، ونظرا لاختلاف الثقافة من أمة إلى أخرى استنادًا إلى الواقع المشاهد فإن لكل أمة حضارة تحمل خصائصها، وعليه فهناك مجموعة حضارات لا حضارة واحدة هي الحضارة الغربية فقط كما يروِّجُ بعضُ مفكِّري الغرب.
إن الأداء التِّقني يحتاج إلى أداء أخلاقي، وحينئذ يكون الناتج إيجابيًّا آمنًا، فإذا ضعف أو غاب الأداء الأخلاقي عن الأداء التِّقني فالناتج الحضاري سيكون سلبيًّا وربما مدمِّرًا، بينما إذا غاب أو ضعف الأداء المادي عن الأداء الأخلاقي فالناتج الحضاري سيكون أحلامًا وآمالًا ورسومًا نظرية وهمية لا روح فيها ولا حياة.
يحدثنا التاريخ عن حضارات قامت وأبدعت وفق معطيات زمانها بيد أنها اندثرت وبادت بخلل في أدائها أو خواء فيها، منها الحضارة البابلية والفرعونية والفارسية واليونانية والرومانية، ويحدثنا القرآن الكريم عن قوم عاد وثمود وغيرهم ممن أقاموا حضارات وأشادوا صروحًا عمرانية بيد أنهم ظلموا وطغوا وأفسدوا في الأرض؛ فانهارت دولهم وهوت صروحهم ولم تبق لهم باقية، يقول الله تعالى: {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا} [الكهف: 59].
إن ما ذكره القرآن الكريم ونص عليه من هلاك الحضارات بسبب الظلم والفساد واختلال الأداء هو ما يكرره اليوم قادة الحضارة المادية الغربية والشرقية، وقد قدم لنا التاريخ المعاصر شهادات كثيرة من أفواه زعماء معروفين، وكلهم يؤكدون لنا أن أخطر ما يهدد المسيرة البشرية هو اختلال الأداء الحضاري واختلال العلاقة بين الإبداع التقني والأداء القيمي السلوكي، فها هو ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي المندثر يقول في آخر سنوات الاتحاد: (رغم الانتصارات العلمية والتكنولوجية نجد نقصًا واضحًا في الكفاءة في استخدام المنجزات العلمية) ويقول: (لقد بدأ التدهور التدريجي في قيم شعبنا الإيديولوجية والمعنوية، وبدأ الفساد يسري في الأخلاقيات العامة) وقال أيضا: (مهمتنا اليوم أن نرفع روح الفرد، ونحترم عامله الداخلي، ونعطيه قوة معنوية ليكون مستقيما حي الضمير).
وتحدث عن وضع المرأة السوفييتية فقال: (عجزنا عن إيلاء اهتمامنا لحقوق المرأة الخاصة، ولدورها أمًّا وربة منزل، لم يعد للمرأة وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل وتربية الأطفال وإضافة جو أسري طيب…، لقد اكتشفنا الكثير من مشكلاتنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا، وهذه نتيجة متناقضة لرغبتنا سياسيًّا في مساواة المرأة بالرجل في كل شيء؛ لهذا نجري مناقشات حول دور المرأة في رسالتها النسائية البحتة)([1]).
المنظومة الليبرالية
إذا أخذنا هذه المنظومة من خلال مقولة نهاية التاريخ، فإن هذا يعني أن الغرب في حالة من التفاؤل إلى درجة المبالغة، وإذا أخذناها من خلال نظرية صدام الحضارات فهذا يعني أن الغرب يعيش حالة حذر وقلق مستمر من المستقبل، وهاتان المقولتان من أهم وأبرز المقولات والأفكار التي صدرت عن الغرب في تفسير مستقبل التحولات العالمية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، واستقطبت اهتمامًا عالميًّا، وفتحت حوارات جادة في مختلف قارات العالم.
وقد كشف عن هاتين الحالتين زبغنيو بريجينسكي في كتابين من تأليفه، كان في الأول متفائلًا، وهو كتاب (الفشل الكبير: ميلاد وموت الشيوعية) الذي صدر عام 1989م، وفي الثاني حذرًا قلقًا، وهو كتاب (الانقلاب: الاضطراب عشية القرن الواحد والعشرين) الذي صدر في عام 1993م.
ويعبر عن هذا القلق كيشوري محبوباني من سنغافورة فيقول: (في العواصم الغربية الأساسية إحساس عميق بالقلق تجاه المستقبل، فالثقة بأن الغرب سيظل قوة مسيطرة في القرن الحادي والعشرين مثلما حدث في القرون الأربعة الماضية تخلي مكانها لإحساس بنُذُرِ الشر من قُوى مثل الإسلام الأصولي المنبعث ونهوض شرق آسيا، وانهيار روسيا وأوروبا الشرقية؛ مما قد يشكل تهديدًا حقيقيًّا للغرب) ويختم مقالته التي جاءت في معرض نقد صدام الحضارات بقوله: (على المرء أن يقف خارج الغرب ليرى كيف أن الغرب يتسبب في انهياره النسبي بيديه)([2]).
الغرب والانبعاث السياسي على مستوى الإيديولوجيات والديانات
وبوضوح أكثر تلمس هذا القلق في التقرير الاستراتيجي السنوي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وهو تقرير رامسس (Ramsès) 1995م[3]، ولا يتسع المجال هنا لرصد كل الأفكار والآراء التي تكشف عن حالة القلق التي يعيشها الغرب تجاه مستقبله في العالم، لكن الآراء التي تكثر في هذه السنوات الأخيرة تخلص إلى أن أبرز المنظومات العالمية الكبرى تمر بتحولات ومراجعات، فالعالم بين منظومة انهيار هي الشيوعية، ومنظومة في حالة قلق هي الليبرالية، ومنظومة تعيش الانبعاث وهي الإسلام.
هذا على مستوى الإيديولوجيات، أما على مستوى الديانات فالحقائق تشير إلى أن الإسلام من بين الديانات الأخرى -المسيحية واليهودية والديانات الشرقية- هو الأكثر انتشارًا بين الأمم والشعوب في قارات العالم، وهذا ما يتوجس منه الغرب وأصحاب الديانات، ومن أبلغ هذا التوجس ما ورد في منشور البابا يوحنا بولس الثاني، الصادر في أواخر 1990م، وفيه يحذر الغرب من أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتحدى انتشار المسيحية، وهناك تزايد في الإقبال على الإسلام، وانحسار في المناطق المسيحية في الشرق الأدنى وإفريقيا، وهناك جسور للإسلام تتزايد في جنوب أوروبا([4]).
والظاهرة التي تلفت أنظار الغرب وتحيره هو النمو المتزايد للإسلام في داخل المجتمعات الغربية، وهي التي تخضع لدراسات مكثفة موسعة لمعرفة أسبابها، ومصدر الحيرة عند الغرب هو كيف لهؤلاء أن يتخلوا عن الحداثة بعد كل المنجزات الهائلة التي قدمتها الحضارة الغربية، ويذهبوا إلى الإسلام الذي يفتقد هذه الحداثة، وليست له من المنجزات الحضارية ما يقارن بما عند الغرب اليوم؟!
ومن جهة أخرى فالغرب الذي عمل عدة قرون على محاصرة الإسلام في عقر داره ومنعه من الانتشار والامتداد خارج محيطه ينتبه اليوم فإذا بالإسلام على أبوابه، يخترق حصون الحداثة والتقنية والتقدم، ويشهد على هذه الظاهرة كتاب من إيمان إلى آخر الذي صدر في النصف الثاني من عقد الثمانينات من هذا القرن في فرنسا وأثار ضجة في وقته في المجتمعات الغربية، وهو من تأليف الفرنسية ليزبت روشيه والمغربية فاطمة الشرقاوي، إذ أمضيتا ثلاث سنوات من البحث في أوروبا وأمريكا لمعرفة الأسباب التي تدفع الغربيين إلى الإقبال على اعتناق الإسلام.
بحسب دراسة المؤلفتين فإن الجميع يعتقد أن الإسلام يقدم الخلاص بعدما أصيبت الحضارات الغربية بتصدعات حولت الإنسان إلى مجرد تمثال، وقد ذكرت الدراسة أعداد الداخلين في الإسلام بالأرقام([5]). وتضيف أن ما يلفت نظر الباحثين أن الإسلام هو الديانة الوحيدة الأكثر توسعًا في هذا العصر بينما تتقلص الأديان الأخرى، وجاء في الكتاب أيضًا أنَّ موظفًا في الخطوط الفرنسية أخبرهما أن بين يديه الآن أربعين جواز سفر تعود لمواطنين فرنسيين اعتنقوا الإسلام أخيرًا، وأن هؤلاء حجزوا أماكن لأداء فريضة الحج، ومنذ تلك اللحظة -كما تقول الكاتبتان- قررنا أن نقوم ببحثنا في أوروبا وأمريكا، ومما جاء في الكتاب: (إن أهم ما توصلنا إليه أن الدوافع العقائدية لدى كل شخص أو لدى كل فئة كانت مختلفة من شخص لآخر ومن فئة لأخرى، وهذا يعكس الثراء العقائدي الذي في الإسلام)([6]).
هذه الحقائق من أهم أسباب الانشغال العالمي الواسع بقضايا الإسلام والفكر الإسلامي والعالم الإسلامي. وأما في العالم العربي والإسلامي فقد استحوذ الفكر الإسلامي على اهتمام واشتغال كل التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية التي يقلد كثير منها الغرب في اهتماماته ودراساته.
الفكر الإسلامي من التنظير إلى الحركة
بعد سقوط الحتمية الشيوعية وظهور الصحوة الإسلامية بوصفها خيارًا حضاريًّا لأمة بقيت في طي النسيان عقودًا، حدثت تطورات في المشروع الإسلامي عالميًّا، وهذا ما دفع الغرب لتجديد اهتمامه بدراسة الإسلام، خصوصا أن الفكر الإسلامي تخلص من حالة الجمود التي أصابته واندفع نحو الحركة على أرض الواقع، وأبدى اهتمامًا واسعًا بالقضايا العالمية المعاصرة، وكان من أبرز مظاهر التطور في الفكر الإسلامي انتقاله من العلماء إلى جماهير الأمة.
الفكر الإسلامي منظومة ثقافية حضارية تمثل مادة حيوية في الاشتغال الفكري على النطاق العالمي اليوم، وهو في هذا الجانب يتقدم على أهم المنظومات الثقافية والدينية والسياسية في العالم، فنحن نشاهد تحولات كبرى وانهيارات كبرى، وفي مقدمة هذه التحولات الثقافية انهيار المنظومة الشيوعية التي خرجت من دائرة الحداثة إلى دائرة التراث، تلك المنظومة التي قدمت نفسها إلى العالم عامة وللغرب خاصة بديلًا حضاريًّا عن الليبرالية الرأسمالية، ودخلت معها في حرب باردة خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية.
إلى جانب هذا السقوط كان هناك اختيار حضاري آخر هو الصحوة الإسلامية، وجد فيها روجيه غارودي الفرنسي ونخبة من مثقفي العالم العربي والإسلامي ما يعوضهم عن الشيوعية، وإلى جانب التحولات والانهيارات التي شهدتها قوى عالمية عدة كان هناك الانبعاث الإسلامي الآخذ بالنمو والاتساع على امتداد رقعة العالم الإسلامي، ذلك الانبعاث الذي أراد فوكوياما أن يقلل من أهميته في مقولة (نهاية التاريخ) الشهيرة، فرأى أنه لا جاذبية له خارج محيطه الإسلامي، ولا تأثير له على المستوى العالمي بعكس ما ذهب إليه هنتنغتون في مقولته صدام الحضارات من أن الدين مركزي في العالم المعاصر، وأراد أن يلفت نظر الغرب إلى صعود الإسلام الذي قد يكون الأكثر خطرًا في صدام الحضارات مع الغرب مستقبلا([7])، الأمر الذي يراه إدوارد سعيد إحياء لروح الحرب الباردة حيث أصبح الإسلام هو العدو بدل الشيوعية([8]).
الفكر الإسلامي بين التراجع والانبعاث
بعد زمن طويل من الانحسار والتراجع الحضاري بات الاعتقاد عند أوساط عالمية كثيرة في الغرب والشرق وحتى بين المسلمين بأنه لا عودة للإسلام، خاصة بعد أن اكتسحت الحداثة والعلمانية العالم، ففي ظل هذا الاعتقاد الذي ما كان ليقبل الشك في نظر قائليه ظهر الانبعاث الإسلامي بزخم كبير ليفاجئ العالم ويعود إلى حلبة التاريخ المعاصر في أشد مراحله التاريخية حساسية، حيث الهزات العنيفة في كل جهات العالم، والمخاضات الخطيرة في كل جانب منه، في السياسة والفكر والاجتماع، والاقتصاد والإعلام والجغرافية والتقنيات والطب وغير ذلك، وهي المخاضات التي سبقت التحولات الحضارية المهمة.
والانبعاث الإسلامي الذي جاء مع هذه الأوضاع إنما جاء ليؤكد حضور الإسلام في هذا العالم مهما كانت مستويات التقدم التي وصل إليها، وأنه ليس في قدرة أحد -مهما كانت القوة التي يملكها- أن يعزل الإسلام أو يغيبه عن حركة التاريخ، وإن القناعة تتأكد من وقت لآخر في هذا العالم بأن الإسلام من الممكن أن يكون أحد الخيارات الحضارية العالمية البديلة كما عبر عنه المفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان في كتابه (الإسلام كبديل)([9])، أو روجيه غارودي في كتابه (الإسلام دين المستقبل)([10])، أو عزت بيجوفيتش في كتابه (الإسلام بين الشرق والغرب)([11]).
هذه الكتابات تكشف عن ظاهرة آخذة في النمو والاتساع داخل المجتمعات الغربية، إنها ظاهرة تستوقف اهتمام الغرب وتثير حالة من الحذر في طريقة التعامل معها، وهكذا يقف النظام العالمي اليوم بين منظومة تنهار هي الشيوعية وأخرى تتصاعد هي الإسلام.
انتقال المشروع الإسلامي إلى إدارة الحكم والدولة والمجتمع
خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين انتقل الفكر الإسلامي من مرحلة الدفاع عن الذات إلى مرحلة الهجوم، ولكن لم ينته القرن العشرين حتى وجد الفكر الإسلامي نفسه مدفوعا بطاقة قوية لاشتغالات فكرية جديدة، فرضتها عليه متغيرات المرحلة التي اتصفت بكثافة حوادثها وسرعة حركتها وخطر نوعيتها، فما كان من الفكر الإسلامي إلا أن توجه بأفكاره إلى هذه المرحلة، يتأمل تحدياتها وإشكالياتها ومتطلباتها وتساؤلاتها.
وقد أبدى الفكر الإسلامي استجابات عميقة لمتطلبات العصر، تلك الاستجابات التي لا يُضمن لهذا الفكر حضوره ومعاصرته ومواكبته إلا بها، وخصوصًا أن الأنظار كانت متوجهة إليه من كل الجهات بعد أن سجل حضورا واسعا على مستوى المشروع الإسلامي الذي انتقل إلى إدارة الحكم والدولة والمجتمع لأول مرة في التاريخ المعاصر، فكان موضع تساؤلات ومناظرات ومطارحات من كل الاتجاهات والتيارات من داخل العالم الإسلامي ومن الغرب ومن داخل الفكر الإسلامي نفسه، الذي أخذ ينظر إلى ذاته ويراجع ما عنده من إجابات وتطورات وبدائل، فاكتشف أنه أمام مرحلة دقيقة وحساسة لم يعدَّ نفسه لها فكريًّا ومعرفيًّا، وأنه بحاجة إلى أن يحرك طاقته الاجتهادية والتجديدية ليكون في مستوى المرحلة وتحدياتها واحتياجاتها الفكرية، ويستجيب لمنطقة الفراغ التي كشفت عنها المستجدات المعاصرة، فكانت محاولات الاجتهاد والتجديد والنقد والمراجعة والتأصيل بحثًا عن البدائل والتصورات الإسلامية في مختلف الميادين السياسة والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية.
نتيجة لمسيرة التجديد البناء وصل حملة الفكر الإسلامي إلى إدارة المجتمع والدولة في بعض البلدان، ووجدوا أنهم أمام مهام فكرية ضخمة جدًّا بحاجة إلى وقت غير قليل لملاحقتها، فأوضاع البلاد كانت تتطلب إصلاحات جذرية وشاملة، وكانت مشكلات الواقع أكبر من التوصيف النظري والعملي.
وهكذا هو الحال مع التجارب الإسلامية الأخرى التي وإن لم تصل إلى مرحلة إدارة المجتمع والدولة إلا أنها انتقلت من طور السرية إلى طور العلنية والتعامل مع الواقع، ومن حركة الذات إلى الوجود الآخر المتعدد المختلف، وثمة فرق كبير بين أن يكون هذا الاختلاف سياسيا أو منهجيا في إطار المرجعية الفكرية الواحدة وبين أن يكون مع المخالف لك إيديولوجيًّا وفكريًّا.
إن الأوضاع التي عاشها الفكر الإسلامي في الفترة الأخيرة دفعته للاختيار بين أشكال العلاقات التي يريد أن يدخلها، وقد تعددت هذه الخيارات بين الانغلاق أو خيار الصدام أو خيار التعايش أو التلافي، وقد كانت توقعات المراقبين تشير إلى أن الصحوة الإسلامية سوف تصطدم بمحيطها نتيجة ما كان يمر به الواقع من متغيرات سريعة لم يوازها تجديد كاف في منظومة الأفكار عند الجماعات الإسلامية، ولكن مجموعة من حملة الفكر الإسلامي استطاعت أن تتعامل مع الواقع وتتعايش معه محافظة على نفسها ومتأقلمة مع المتغيرات التي تحيط بها.
وقد تطرق للحديث عن هذه القضية الأستاذ راشد الغنوشي في عام 1982م في مقالة نشرها تحت عنوان (الفكر الإسلامي بين المثالية والواقعية)، فهو يعتقد أن العقلية المثالية تؤدي إلى العجز عن استيعاب الواقع وتوليد فكر إسلامي يقدم للمسلم وعيًا صحيحًا بذلك الواقع وقدرة على تسخير طاقاته لصالح مشروعه الإسلامي الحضاري([12]).
هذا عن المتغيرات الذاتية في المشروع الإسلامي المعاصر التي انعكست على حركة الفكر الإسلامي، أما عن التغيرات الموضوعية فأبرزها أن العالم الإسلامي الذي كان يلفه النسيان عن الساحة العالمية، ويعيش في داخله حالات من الركود والجمود طوال عقود: انتقل مع أواخر السبعينات إلى وضع آخر مختلف، وأخذ في الانبعاث والنهوض حتى إنه يتصدر واجهة الاهتمامات العالمية، ويستقطب الاهتمام بصورة غير مسبوقة، فالأوضاع انتقلت من الركود إلى حركة لا تهدأ، والأحداث تلاحقت بسرعة، والجميع بدأ يتابع بحذر شديد.
هذه الأوضاع بعثت على تأملات وقراءات جديدة للواقع الإسلامي لتشخيصه وتقويمه، ولتحديد أولوياته واحتياجاته التي أكدت ضرورة تحريك الفكر الإسلامي نحو الاشتغال بالمتطلبات والحاجات الجديدة، فكانت تدفع نحو مسارات جديدة في حركة الفكر الإسلامي.
([1]) باختصار من كتاب البيريسترويكا ص 9/18/138/272 للرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف.
([3]) جريدة الحياة (لندن)، العدد 11798-12 يونيو 1995م.
([4]) الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين: د.شوقي أبو خليل، بيروت/دار الفكر المعاصر، 1995م، ص 10.
([5]) الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري ص 25.
([6]) الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري، ص 25، زكي الميلاد، دار البيان العربي 1991م.
([8]) صراع الحضارات أو خلافات في التعريف، جريدة الحياة (لندن)، العدد 11686، 17 فبراير 1995م، إدوارد سعيد.
([9]) ترجمَ هذا الكتاب الأستاذ محمد مصطفى مازح 1993 في بيروت، وكان المؤلف سفيرًا لألمانيا في المغرب.
([10]) صدر الكتاب عن دار الإيمان في بيروت، ترجمة عبد المجيد بارودي، 1983.
([11]) صدر الكتاب عن دار الشروق بالقاهرة بالتعاون مع مجلة النور الكويتية ودار بافاربا الألمانية، 1994م.
([12]) محاور إسلامية، راشد الغنوشي، الخرطوم، بيت المعرفة 1989م، ص27.