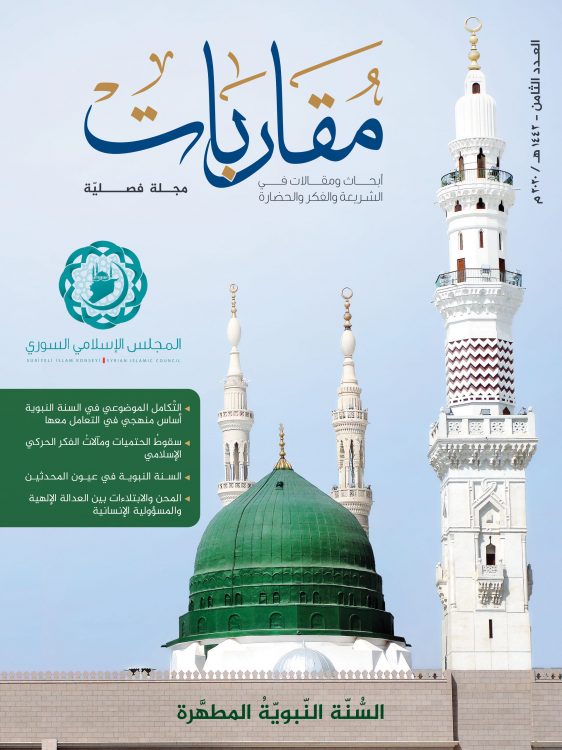الاقتصاد الإسلامي باب من أبواب الدعوة إلى الله تعالى
سبتمبر 14, 2020
سقوطُ الحتميات ومآلاتُ الفكر الحركي الإسلامي
سبتمبر 14, 2020المعيار الشرعي لطلب الشهادة

تحميل البحث كملف PDF
الشيخ: عبد العظيم عرنوس
حفظ النفس البشرية المؤمنة إحدى الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، فهي نفس ثمينة غالية، جدير بأن تحفظ من التلف ولا تُهدر بلا كبير فائدة، روى ابن حبان أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما نظر يومًا إلى البيت فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك! وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك وروى ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل يعوده قال: ((اللهم اشفِ عبدَك، ينكأ لك عدوًّا، أو يمشي لك إلى صلاة))([1]).
وحياة المؤمن في سبيل الله غاية منشودة، وهي أشق وأصعب من الموت في سبيل الله، والحياة في سبيل الله أصل، والموت في سبيله استثناء، والذين يجيدون الحياة في سبيله هم الذين يحركون دفة النهضة والبناء وعمارة الأرض.
وكثير من المؤمنين المجاهدين يتشوفون ويتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله دون أخذ الأهبة وإعداد العدة المستطاعة التي ترهب العدو وتوقع النكاية والإثخان فيه، هذا مع انعدام أخذ الحيطة والحذر، وتجاهل فقه الإقدام والإحجام، وإغفال الحيل الشرعية التي تخدع العدو، حتى الكذب الذي لا يُطبع عليه المؤمن وهو من الكبائر مرخص فيه في الحرب، وغير ذلك من أمور كثيرة تراعَى لحفظ النفس من الضياع والقتل.
والجهاد في سبيل الله إنما شرع ليحيا الناس حياة كريمة سعيدة هانئة، لا يخافون من العدوان عليهم، فيشيع الأمن والأمان في المجتمع المسلم، ويستطيع المرء أن يؤدي شعائر دينه وأوامر ربه دون خوف أو وجل، فالإقدام حيث يجب الإقدام واجب، والإحجام حيث يجب الإحجام واجب، وهذا يحتاج إلى موازنات وفقه دقيق وتغليب للمصالح على المفاسد، الأمر الذي يفتقده أغلب المجاهدين وقادتهم، قال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أعياني أن أعرف أشجاعٌ أنت أم جبانٌ؟ تُقدِم حتى أقولَ: مِنْ أشجعِ الناسِ، وتَجبن حتى أقولَ: مِن أجبنِ الناس) فقال: (شجاع إذا ما أمكنتني فرصة…، فإن لم تكن لي فرصة فجبان)([2]). وكان العربي الجاهلي يدرك هذا بتجربته، قيل لعنترة: (أنت أشجع العرب وأشدها؟) قال: (لا) قيل: (فبماذا شاع لك هذا في الناس؟) قال: (كنت أُقْدِم إذا رأيت الإقدام عزمًا، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزمًا، ولا أدخل إلا موضعًا أرى لي منه مخرجًا)([3]).
ومن نافلة القول أنّ الشهادة في سبيل الله وسيلة لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، وليست غاية، قال المثنى بن حارثة في معركة الجسر: (هلك قوم جعلوا الشهادة غايتهم فحسب!).
والمؤمن ينال درجة الشهداء بنيته الصادقة وإن لم يصبها، روى مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سأل الله الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه))([4]) قال العز بن عبد السلام: (قال الله تعالى: {وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:74]، فجعل الأجر العظيم للقتلى والغالبين، والغالب أفضل من القتيل لأنه حصّل مقاصد الجهاد، وليس القتيل مثابًا على القتل لأنه ليس من فعله، وإنما يثاب على تعرضه للقتل في نصرة الدين)([5]).
الشهادة بذاتها ليست غاية، فلو كانت غاية فلِمَ أمر الله بأخذ الحيطة والحذر، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71]، ولِمَ شرعت صلاة الخوف إذًا، قال عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102] ولِمَ أمر الله بإعداد العدة، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] ولِمَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع والمغفر في الحرب؟ روى أبو داود (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ظاهرَ يومَ أُحُدٍ بينَ دِرعَينِ، أو لبسَ دِرعَينِ). ولماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين بعثهم في سرية وقالوا له نحن الفرَّارون، فأشاد بهم بقوله ((بل أنتم العكَّارون))، رواه الترمذي. هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أن دماء المسلمين غالية، والتفريط في حماية الأنفس دونما كبير فائدة يُعَد جريمة عظيمة ترتكب في حق الدين والناس، فالنفس ملك لله وليست ملكًا للقادة أو للشخص نفسه، روى ابن ماجه بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)).
حقوق المقاتلين على القادة:
مما سبق يتبين أن للمقاتلين حقوقًا على القادة، ومن أهمها الحفاظ على أرواحهم، يقول الدكتور محمد خير هيكل: (الحفاظ على أرواح الجنود: حول قيمة هذا الحق وأثره في تحقيق النصر يقول أحد قادة الحروب الحديثة مونتغمري: (القائد الذي يحرص ويُعنى أشد العناية بالمحافظة على أرواح رجاله يستطيع أن يحقق النصر بأقل الخسائر في الأرواح؛ لأنه يحصل على ثقة جنوده، وبذلك سيتبعونه عن إيمان وثقة راسخة) ويقول الشيخ تقي الدين النبهاني مبيِّنًا مكانة الجنود في الدولة وضرورة المحافظة عليهم: (يجب على الخليفة أن يقدر مكانة العسكريين العالية في الدولة سواء من حيث الدفاع عن البلاد أو من حيث بدء الكفار بالقتال؛ ولذلك يجب عليه وعلى الأمة كلها المحافظة على القوة العسكرية كما يحافظ الفرد على حبة عينه).
هذا، وبدهي أنه لا يراد بالمحافظة على أرواح الجنود أو القوات العسكرية هو إبعادها عن خوض الحروب على الإطلاق حتى لا تتعرض لأي خطر، وإنما المراد هو عدم اللجوء إلى الحرب إلا على ضوء الأمور التالية:
أولًا: أن يكون لا مناص من خوض الحرب تبعًا لأسباب إعلان الجهاد في الإسلام.
ثانيًا: أن يكون القرار بخوض الحرب -بعد إعداد القوة التي ترهب العدو ما أمكن ذلك- كما قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] إذ مع إعداد هذه القوة الرهيبة يكون العدو بين خيارين -وكلاهما يحقق للجيش الإسلامي المحافظة على أرواح مقاتليه ما أمكن-:
– إما خيار الحرب بعد أن تكون الرهبة من القوة الإسلامية قد فعلت فعلها في نفوس العدو، فیندحر بأقل الخسائر.
– وإما خيار المفاوضات السلمية، والاستجابة في النهاية لمطالب المسلمين بما فيه مصلحة الدعوة الإسلامية ومصلحة الإنسانية جمعاء؛ وبذلك تتم المحافظة على أرواح المقاتلين.
ثالثًا: عدم تعريض المسلمين للمغامرات التي لا تعود على المسلمين بكبير فائدة.
رابعًا: ألَّا يكون الإقدام على الحرب لتمهيد الطريق أمام الدعوة إلا بعد تقدير الظفر فيها، يقول الإمام الشافعي فيما يجب على إمام المسلمين في هذا: (وجب عليه أن يدخل المسلمين بلاد المشركين في الأوقات التي لا يغرر بالمسلمين فيها، ويرجو أن ينال الظفر من العدو).
ومن أجل المحافظة على أرواح الجنود كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: (لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين)؛ وذلك أنه كان شديد الجرأة ويقتحم في المهالك، فإذا وضعت القيادة في يده ربما حمل الجيش على عمليات تزهق فيها أرواح كثيرة، وكان عمر بن الخطاب لشدة حرصه على أرواح جنوده يقول: (والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم).
ولا عجب أن يحرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أرواح جنوده، وهو غرسة من غراس النبوة في هذا المجال وفي كل مجال حميد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بادي الحرص على جنوده من أي أذى قد يصيبهم به العدو، ومما يُذكر في هذا ما جاء في صحيح مسلم من أخبار غزوة الخندق أنَّ فتى كان (يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة)) هذا ما يتعلق بالمحافظة على أرواح المقاتلين في الجيش الإسلامي)([6]).
التعرض للشهادة وطلبها
مما لا شك فيه أن الشهيد منزلته عظيمة عند الله، والقرآن الكريم قد نوه وأشاد بمنزلة الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض في أحاديث كثيرة بما أعد الله لهم بل إنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن يغزو مرارًا فيقتل، وقد وضع الفقهاء شروطا وضوابط لجواز التعرض للشهادة وطلبها، ووزنوا الأمر بالموازين الدقيقة التي تحقق المقصد من ورائها بما يعود بالنفع على الأمة، ومن ذلك مسألة حمل الفرد على العدد الكثير من الأعداء، قال ابن حجر في الفتح: (وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرِّئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم)([7]).
وجاء في شرح السير الكبير للسرخسي: (لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يُقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يَقتل أو يَجرح أو يَهزِم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يُقتل فقط، وقد قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29])([8]). فالشرط عند الفقهاء غلبة الظن بإيقاع النكاية في الأعداء وترهيبهم والتأثير بهم.
قال القرطبي: (اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بِنيّة خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان؛ إن علم وغلب على ظنه أنْ سيَقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يُقتَل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيلًا من طين وأنَّس به فرسه حتى ألفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يَقْدُمُها فقيل له: إنه قاتلك، فقال: لا ضير أن أُقتل ويُفتح للمسلمين) ثم استدل القرطبي بفعل البراء بن مالك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، فقال: (ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب).
ونُقل عن محمد بن الحسن: (لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعةً للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ…} الآية [التوبة: 111])([9]).
وفي طبقات الشافعية قال العز بن عبد السلام: (والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين؛ ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر في صفوف المشركين، ومن قال بأن التغرير بالنفوس لا يجوز فقد بَعُد عن الحق ونأى عن الصواب، وعلى الجملة فمن آثر الله على نفسه آثره الله)([10]) وهذا كما سبق بشرط إيقاع النكاية وإضعاف شوكة الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا ما يؤكد وجود غايات ومقاصد جليلة من وراء استحباب أو وجوب التعرض للشهادة.
وقد ترد شبهة المغامرة بسبب حديث صاحب التمرات المشهور في غزوة بدر، ففيما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ))، قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: (يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟) قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: (بَخٍ بَخٍ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟)) قَالَ: (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا)، قَالَ: ((فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا))، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ)([11]).
والذي يدحض هذه الشبهة أن الموقف والمجال كان موقف إقدام وإظهار للبطولة وإرهاب للعدو بتحفيز وتحريض من الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، فالحذر الحذر من التهور والتعجل في طلب الشهادة دون ثمرة تُرتجى ولا غايات شريفة من ورائها.
وليس في شيء مما ذكرنا التهوين من منزلة الشهادة ومكانة الشهداء العالية عند الله، أو الغض ممن بذلوا أرواحهم في سبيل الله، بل الغاية والغرض تبيان اللبس الذي قد يقع في بعض الأذهان ويوهم أن طلب الشهادة هو الأصل؛ بل المقصد الأسمى والأصل الأصيل من رسالة السماء هو العيش والمجاهدة لتحقيق عبادة الله وتحكيم منهجه وشريعته في الأرض سواء تحقق ذلك بالموت في سبيل الله عندما يتطلب الأمر، أو بالحياة والعيش في سبيل الله، فكلاهما مطلوب، والظرف هو الذي يحكم أيهما أرجح في وقته، فالله سبحانه لم يفرض القتال إلا بقدر الحاجة إليه؛ الأمر الذي يستدعي جهوزية الأمة في كل وقت وظرف وحينٍ للدفاع عن دين الله تعالى، وألا تكون الغاية هي الموت فحسب دون تحقيق الغايات المنشودة.
([1]) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، باب عيادة المريض. قال ابن حجر وشعيب الأرنؤوط: حسن.
([2]) الفوائد لابن القيم، ص (143)، دار الكتب العلمية، ط 1973م.
([3]) رجال المعلقات العشر: مصطفى الغلاييني.
([4]) رواه مسلم في صحيحه، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم (157).
([5]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام، ج 1 فصل في بيان رتب المصالح.
([6]) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ج 2 ص 1125.
([7]) فتح الباري لابن حجر، ج 8، باب قوله تعالى {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
([8]) شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ج 1، باب من يحل له الخمس والصدقة.
([9]) الجامع لأحكام القرآن، ج 2، بتصرف.
([10]) طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ج 8.