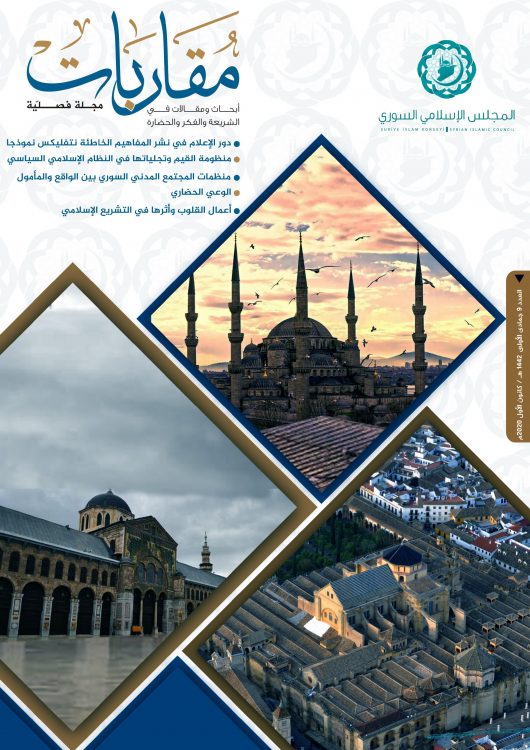منظومة القيم وتجلياتها في النظام الإسلامي السياسي
يناير 4, 2021
تاريخنا والنقد
يناير 4, 2021أعمال القلوب وأثرها في التشريع الإسلامي

تحميل البحث كملف PDF
د. محمد تركي كتوع – دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله مدرس في أكاديمية باشاك شهير
مقدِّمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:
إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية، ولذلك كانت متصفة بالكمال والشمول والبقاء والخلود، هدفها تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، فرسالتها متوازنة تحقق التناغم والانسجام بين الدين والدنيا، والروح والجسد، اهتمتْ بصلاح القلب وصفائه واستقامته كاهتمامها بالجسد وصحته وسلامته، ولكنها في الوقت ذاته أعطتْ القلب دور الريادة والقيادة والتوجيه، والجوارح تستجيب لندائه وتخضع لسلطانه، فالقلب هو المحور والمركز والقائد، وبأمره يتحرَّك الجسد، وكلُّ قلب بالذي فيه ينضح، فإذا استقام القلب استقام الجسد، وإذا مال القلب مال الجسد.
أهمية الموضوع:
إنَّ هذا الموضوع له أهمية كبرى في الواقع العملي؛ لأنَّ أغلب الفساد الذي نراه في سلوك المكلفين وانحراف الجوارح وعصيانها سببه الرئيسي فساد القلب وخرابه، لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بشأن القلب وجاءت الأوامر بضرورة تعهّده ومراقبته، لعِظم المصالح المترتبة على مراعاته وإصلاحه، وفداحة المفاسد والأضرار المترتبة على إهماله وإغفال شأنه.
قال الإمام الغزالي: (الجوارح أتباع وخدم وآلات، يستخدمها القلب، ويستعملها استعمال المالك للعبد، واستخدام الراعي للرعية، والصانع للآلة… وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرِّد على الله تعالى، وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره، وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه)([1]).
وقال أيضًا: (كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح، حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعلٍ يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب)([2]).
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وعظيم أثره في الواقع العملي أردتُّ الإضاءة عليه ولفت الانتباه إلى خطره وضرورة الاعتناء بشأنه، فلا صلاح للجوارح دون صلاح القلب، ولذا يجب على العاقل أن يلتفت إلى الاعتناء بسلامته، والحرص على استقامته؛ وبذلك يجني العبد مصالح الدنيا والآخرة، ويدفع عن نفسه الشرور والمفاسد.
أسباب اختيار الموضوع:
ثمة عدَّة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه، من أهمِّها:
1- ما نشاهده في العصور المتأخِّرة من طغيان سلطان المادة على الروح، وكثرة الاهتمام بالجسد وشؤونه وقلَّة الاهتمام بالقلب وإصلاحه، وهذا انقلاب على المفاهيم وخلل في الأولويات، وهذا الخلل ترتب عليه مفاسد كبيرة وأضرار جسيمة، على الفرد والمجتمع، فجاء هذا البحث كمحاولة للفت انتباه المكلَّفين بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك من خلال الاهتمام بصلاح القلب والعمل على تصفيته وتنقيته؛ لأنه الأساس والأصل لسعادة المرء في الدنيا والآخرة.
2- ربَّما هناك من يتوهَّم أن التشريع الإسلامي العملي لا علاقة له بالقلب وأعماله، ويظنّ أن دائرة اهتمام التشريع هي الأحكام الفقهية العملية المتعلّقة بالجوارح فقط، فيظنَّ أنَّ هناك افتراقًا وانفصالًا بين أعمال القلب وأعمال الجوارح، فكان لا بدَّ من التنويه على هذا الخطأ، وأن العلاقة بين القلب والجسد هي علاقة تلازم وتأثير متبادل لا تقبل الانفصال أبدًا.
خطة البحث:
جاء هذا البحث في مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة، كالآتي:
المطلب الأول: العقيدة الإسلامية وأثرها في التشريع الإسلامي، المطلب الثاني: أدلَّة الشرع على الارتباط بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، المطلب الثالث: مؤاخذة العبد على أعمال القلب، المطلب الرابع: الأثر السلوكي المترتب على العلاقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، المطلب الخامس: الحكم على ما في القلوب من شأن الخالق لا المخلوق، والخاتمة.
المطلب الأول
العقيدة الإسلامية وأثرها في التشريع الإسلامي
العقيدة ومبادئها وأصولها كما هو معلوم محلّها القلب، وهذه العقيدة هي التي توجِّه السلوك وتكون أعمال الجوارح على وفقها، قال الطاهر بن عاشور: (أعمال العاملين تجري على حسب معتقداتهم وأفكارهم، فجديرٌ بمن صلحت عقائده وأفكاره أن تصدر عنه الأعمال الصالحة، ولذلك كان أسلوب الإسلام في الأمر بالأعمال الصالحة والنهي عن أضدادها أن يبتدئ بإصلاح العقيدة)([3]).
إنَّ من مميزات التشريع الإسلامي أنه تشريع قائم على العقيدة، فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبدًا من الخارج، إن لم تنبثق وتتعمَّق في أغوار الضمير، فقد ربطَ الإسلام تنفيذ تشريعاته بشعور المؤمن بمراقبة الله تعالى له في كل مكان وفي كل زمان، وجعل هذه المراقبة الضمان الكامن في ذات الأنفس، فوق كل الضمانات الأخرى، فكان للتشريع الإسلامي من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية!
وفي الحقيقة إنَّ هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات، ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات والتنظيمات، وهذه التقوى لا تجيش تجاه التشريعات والتنظيمات إلا حين تكون صادرة من الجهة المطَّلِعة على السرائر الرقيبة على الضمائر، عندئذ يحس الفرد وهو يهم بانتهاك حرمة القانون أنه يخون الله، ويعصي أمره، ويصادم إرادته؛ وأن الله مطَّلِع على نيته هذه وعلى فعله، وعندئذ تتزلزل أقدامه، وترتجف مفاصله، وتجيش تقواه، فالله تعالى أعلم بعباده، وأعرف بفطرتهم، وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي-فهو خلقهم- ومن ثم جعل التشريع تشريعه، والقانون قانونه، والنظام نظامه، والمنهج منهجه، ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته، وقد عَلِمَ- سبحانه- أنه لا يطاع أبدًا شرعٌ لا يرتكنُ إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب، وتعرف أنها مطَّلِعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب، وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد تحت تأثير البطش والإرهاب والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة، فإنهم لا بدَّ متفلِّتون منها كلما غافلوا الرقابة، وكلما واتتهم الحيلة، مع شعورهم دائمًا بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض([4]).
ولهذا أصبحت القوانين أخيرًا تتطلَّع إلى هذا الجانب العظيم في الشريعة وهو العقيدة، وتحاول جاهدة التوفيق بينه وبين قواعدها، وتسعى لتقنين القواعد الأخلاقية في قواعد قانونية تدريجيًا، وكان هذا أمل الفلاسفة والمصلحين في الماضي، وهو أمل البشرية في الحاضر، ومهما حاولت بعض القوانين التنكُّر للعقيدة فسرعان ما تعود إليها تتلمَّس فيها الحلول عندما تقف عاجزة عن ضبط تصرفات الأفراد، ويفلت الزِّمام منها، فجميع القوانين لجأت إلى ذلك في مجال الإثبات عندما تضاءلت الوسائل المادية عن الوصول إلى الحقيقة، وتوقَّفَتْ حائرةً أمام المتداعيَين، فاضطرت إلى العودة إلى العقيدة، تستنجد بقواعدها، وتلتجئ إلى عرينها، وترضى بالاحتكام إلى ضمير الخصم وعقيدته، وتطلب منه اليمين على الفعل أو عدم الفعل، وعلى الاستحقاق وعدم الاستحقاق.
قال الشيخ مصطفى الزرقا: (إنَّ الوازع الديني في صيانة الحقوق مهما ابتعدت عنه الأمم في نزعتها المادية بنظامها الاجتماعي اليوم فقد اضطرت إليه في تشريعها القانوني الوضعي المحض، وبَنَتْ عليه نواحي من قضائها، لم تستطع فيها إلا الالتجاء إلى الضمانة الدينية والوجدان الروحي، ويتجلَّى ذلك في تحليفهم الخصمَ اليمين عند عجز المدَّعي عن إثبات دعواه)([5]).
فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملًا، وهذه الحقيقة أكَّدتها آيات قرآنية كثيرة، تربط بين الإيمان والعمل الصالح، كقوله تعالى: {وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 1-3].
قال الزمخشري: (الإيمان الذي يستحقُّ به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة، هو إيمان مقيَّد، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح، والإيمان الذي لم يُقْرَن بالعمل الصالح، فصاحبه لا توفيق له ولا نور)([6])، “فالإيمان قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة إلى المكرمات، ومن ثَمَّ فإن الله عندما يدعو عباده إلى خير أو ينفّرهم من شر، يجعل ذلك مقتضى الإيمان المستقر في قلوبهم، وما أكثر ما يقول في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا} ثم يذكر – بعدُ – ما يُكلفهم به)([7]).
ولذلك كان تنفيذ الأوامر والنواهي موكولًا إلى دين المخاطَبين، إذ أُنيطَ تنفيذ معظم الوصايا الشرعية بالوازع الديني، وهو وازع الإيمان الصحيح المتفرِّع إلى الرجاء والخوف([8])، فالحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقَّت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد، يملك السلطان على الضمائر والسرائر، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك، فأما حين تتوزع السلطة، وتتعدد مصادر التلقي، حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر، بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع، وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة، بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا، حينئذ تتمزَّق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين، وبين منهجين مختلفين، وحينئذ تفسد الحياة البشرية([9]).
فالعقيدة الإسلامية لها أثر كبير في تربية الضمير، وتهذيب النفس، وتنمية الوازع الديني وتقوية جذوره في القلوب، وبما أنَّ العقيدة محلّها القلب، والعمل والالتزام بالأحكام الشرعية محلُّه الجوارح، لذلك فإنني أنتقل إلى عرض بعض الحقائق التي تُبيِّن وتؤكِّد هذه العلاقة التأثيرية المتبادلة بين القلب والجسد.
المطلب الثاني
أدلَّة الشرع على الارتباط بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح
نذكر فيما يأتي بعض الأدلَّة الشرعية التي تثبت هذه العلاقة المتبادلة والتفاعل المستمر بين القلب والجسد، ومن هذه الأدلة على سبيل المثال لا الحصر:
[1]- قول الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32].
وجه الاستدلال بالآية: يخاطب الله تعالى نساء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس قَدْرُكنّ عندي مثل قدر غيركنَّ من النساء الصالحات، أنتنَّ أكرمُ عليَّ، وثوابُكنّ أعظمُ لديَّ، فلا تَلِنَّ بالقول للرجال، ولا تُرقِّقنَ الكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقيل في مرض القلب هنا أنه النفاق، وقيل: إنه الفجور والشهوة والميل إلى الزنا، فهو لضعف إيمانه في قلبه؛ متهاون بإتيان الفواحش، فدلَّ ذلك على أنَّ ضعف الوازع الديني في القلب هو سبب الوقوع في المخالفات([10]).
والمرض في القلب كالمرض في الجسد، فكما أنَّ هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير موت، فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال من غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه، أو أفسد عمله وحركته، وذلك- كما فسروه-: هو من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده، وإما بضعف عمله وحركته([11]).
[2]- عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ))([12]).
وجه الاستدلال بالحديث: إنَّ صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب”([13])، فالقلب كالملِك، والأعضاء كالرعية، لذلك يجب مراعاته، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرَّك الجسد حركة صالحة وبالعكس، وهذا معنى ما قيل: الناس على دين ملوكهم، والإناء يترشَّح بما فيه([14])، قال الحافظ ابن حجر: (وخُصَّ القلب بذلك؛ لأنَّه أميرُ البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قَدْرِ القلب، والحث على صلاحه)([15])، وقال الطاهر ابن عاشور: (فساد القلب ينشأ عنه فساد الأعمال)([16]).
*وقال أبو الليث السمرقندي: (يُقال: القلب آمرٌ للجسد بالسوء والإثم)([17]).
[3]- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))([18]).
وجه الاستدلال بالحديث: إنَّ نظر الله عزّ وجلَّ إلى القلب فيه دلالة على أهميته وعظيم أثره، وتقديم النظر إلى القلوب على النظر إلى الأعمال في الحديث يدلُّ على أنَّ القلب هو الأساس والمنبع والمصدر، إذ منه تنبعث الأعمال، وعنه تَصْدُرُ التصرفات والأفعال، إذ إنَّ الجوارح مسخَّرة له ومطيعة، فما استقرَّ فيه ظهر عليها، وعملت على مقتضاه: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشرّ، ولمَّا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب ليتصف بها، وبالأمور التي تفسد القلب ليتجنبها([19]).
وجاء في حِكَم ابن عطاء الله السكندري: (تنوَّعتْ أجناس الأعمال بتنوُّع وارداتِ الأحوال).
ومعنى هذه الحكمة: قد تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع الأحوال الباطنة، أو تقول: أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب، فإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره، وهو ترك وإحجام، أي تأخُّر، وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح أثره، وهو كدٌّ وتعب([20]).
المطلب الثالث
مؤاخذة العبد على أعمال القلب
إنَّ العبد مؤاخذٌ بأعماله القلبية كما هو مؤاخذ بأعماله الجسدية، فكلاهما محلٌّ للثواب والعقاب، قال القرطبي: )إنَّ الحَفَظَةَ تكتبُ أعمال القلوبِ؛ خلافًا لمن قال: إنَّها لا تكتبُ إلَّا الأعمال الظاهرة(([21]).
والأدلَّة على مؤاخذة العبد بأعماله القلبية كثيرة، منها:
1-قول الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36].
وجه الاستدلال بالآية: لقد نصَّتْ الآية على أنَّ عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر، في المؤاخذة والحساب، فلا يُعفى عنه([22]).
2- قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [النور:19].
ووجه الاستدلال بهذه الآية: التصريح الواضح بأنَّ العبد يحاسب على حبه لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا الحب من أعمال القلب، فدلَّ ذلك على أن من أعمال القلوب ما يؤاخذ عليه العبد([23]).
3-قول الله تعالى: {وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَهُ} [الأنعام: 120].
وجه الاستدلال بالآية: إنَّ الله تعالى أمر بترك باطن الإثم، وهي المعاصي القلبية، فظاهر الإثم: عمل الجوارح، وباطنه: عملُ القلب، من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين، وقيل: المراد بظاهر الإثم: الإقدام على الذنوب من غير مبالاة، وباطنه: ترك الذنوب لخوف الله عز وجل لا خوف الناس([24]).
4-عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ))([25]).
وجه الاستدلال بالحديث: لقد نصَّ هذا الحديث على أن المقتول صار بمجرَّد الإرادة من أهل النار مع أنه قُتِلَ مظلومًا، فكيف يُظَنُّ أن الله لا يؤاخذ بالنية والهمِّ! بل كل همٍّ دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخَذ به، والنية والهمّ من أعمال القلب([26]).
وهكذا نجد نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة تدلُّ على هذا التلازم الواضح بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأنَّ ما كان في القلب ظهرت وفاضت آثاره على الجوارح.
المطلب الرابع
الأثر السلوكي المترتب على العلاقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح
يقول الإمام الشاطبي في بيان هذا الأثر: (جُعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلًا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرمًا حُكِمَ على الباطن بذلك، أو مستقيمًا حُكِمَ على الباطن بذلك أيضًا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدًا، والأدلة على صحته كثيرة جدًا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن، وكفر الكافر، وطاعة المطيع، وعصيان العاصي، وعدالة العدل، وجُرحة المُجَرَّح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع، وعمدة التكليف، بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة)([27]).
ويقول الغزالي: (لا يَضِيعُ مثقال ذرَّةٍ من الخير والشرِّ، ولا ينفك عن تأثيره في إنارة القلب أو تسويده، وفي تقريبه من الله أو إبعاده، فإذا جاء بما يقرِّبه شبرًا مع ما يبعده شبرًا، فقد عاد إلى ما كان، فلم يكن له ولا عليه)([28]).
فحسنُ أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وكذلك فإنَّ القلب يتأثَّر بحركة الجسد، فإن تحرَّكت الأعضاء للطاعة انبثق من هذه الحركة نور في القلب، وإن تحرَّكت للمعصية انبثق منها ظلمة في القلب، فالعلاقة بين القلب والجسد هي علاقة تأثيرية متبادلة.
ومن هذا الباب فقد حذَّرت الشريعة الإسلامية من التشبه بالكفَّار وتقليدهم في اللباس، وعلَّلَ ابن القيم ذلك بقوله: (المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن كما دلَّ عليه الشرع والعقل والحس)([29]).
هذا ولا يعني التنويه بأهمية أعمال القلوب وأنها الأصل وأعمال الجوارح تبع ومكملة، لا يعني ذلك التقليل من شأن أعمال الجوارح، أو ترك أعمال الجوارح على حساب أعمال القلوب، فأعمال القلوب غالبًا ما تقوم إلا بأعمال الجوارح، كما أن أعمال الجوارح لا تنفعه وتقبل إلا بأعمال القلوب.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهرٌ بلا باطن له، وإن حَقَنَ به الدماء وعَصَمَ به المال والذرية، ولا يُجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذَّر بعجزٍ أو إكراه أو خوف هلاك، فتخلُّف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن وخُلُوِّه من الإيمان، ونقصه دليلُ نقصه، وقوّته دليل قوّته)([30]).
ولذلك نرى أنَّ الخوف وهو من أعمال القلوب يؤثِّر في حركة الجوارح بالكف والإقدام، يكفُّ المسلم عن المعاصي، ويحول بينه وبين مخالفة الشرع والخروج عن أحكامه، فالأثر الحقيقي للخوف يكون بكفِّ الجوارح عن المعاصي وتقييدها بالطاعات، قال القرافي: (الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم)([31])، وقال العز بن عبد السلام: (إنَّ الخوف وازعٌ عن المخالفات لما رتَّب عليها من العقوبات، والرجاء حاثٌّ على الطاعات لما رتَّب عليها من المثوبات)([32]).
المطلب الخامس
الحكم على ما في القلوب من شأن الخالق لا المخلوق
لا يجوز للعبد اتهام الناس بضعف أعمال قلوبهم، أو الحكم على نياتهم وسرائرهم، فما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقاعدة التعامل مع أعمال القلوب والجوارح هي: ((نحن لنا الظاهر والله يتولَّى السرائر)).
والدليل على ذلك:
حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّار))([33]).
وجه الاستدلال بالحديث: لقد ذكرَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعبارة صريحة أنه إنما يقضي بين المتخاصمين بما سمع منهما ظاهرًا، لا بما علمَ عنهما باطنًا، ولا يجوز العدول عن المنهج النبوي في القضاء والتعامل مع العباد، قال الإمام الشاطبي: (فقيَّدَ الحكم بمقتضى ما يسمع وتركَ ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطَّلع على أصلها، وما فيها من حق وباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع، لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه)([34]).
ولقد أفتى الفقهاء المتأخرون من كافة المذاهب بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، سدًّا لذريعة الفساد أمام قضاة السوء، وذلك نظرًا لضعف الوازع الديني، وطغيان حب المادة على النفوس، حتى أصبح علم القاضي الشخصي مكتنَفا بالظنون والرِّيَب، فلا يجوز القضاء على الناس بناء على ما في قلوبهم، وإنما يُحاكَم الناس على ظواهرهم.
ولمزيد الإيضاح نضرب بعض الأمثلة:
المثال الأول:
قد يعمل الشخص عملًا ويفشل فيه، وهنا نجد أن بعض الناس يتخذون من فشل هذا الشخص في مشروعه مطيةً للتسلل إلى قلبه، ويعتبرون فشله دليلًا على فساد قلبه، وسوء طوّيته وسريرته. ومما يبين خطأ هذا الحكم قصة نوح عليه الصلاة والسلام الذي كان من أولي العزم من الرسل؛ فقد كانت زوجته وأحد أولاده كافرين؛ فليس لقائل أن يقول: أين تربيته لولده وزوجته؟! كما أن نتاج دعوته عليه الصلاة والسلام: {وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} [هود: 40]، فلا يمكن لقائل أن يقول: أهذا نتاج دعوة {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت:14]؟!
وفي الحديث: ((عرضت علي الأمم فرأيتُ النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد))([35]).
وفي هذا السياق كم من العلماء الأجلاء في هذه الأمة – وقد شهد لهم بالعلم والفضل – أفنوا جلّ سني أعمارهم في العلم والتعليم، والكتابة والتأليف؛ فمنهم مَن كان له مذهب في الفقه متبع، اندثر مذهبه وعفى أثره، ومنهم من كانت له كتب ومؤلفات فقدت ولم يوجد لها أثر، أو وجد بعض أجزائها، فليس لطاعن أن يطعن في سرائرهم، أو أن يتهم نياتهم؛ فلا يعلم بالنيات إلا رب البريات.
المثال الثاني:
قد يقع شخص في بعض المخالفات الشرعية والمعاصي الظاهرة، ولكن ليس لأحد أن يتهمه في باطنه، وليس هذا تعليلًا أو إعذارًا للعاصي، ولكنه تحذير من اتهام النيات والسرائر.
فقد يكون في قلب من عليه مخالفات شرعية من محبة الله ورسوله ما لا يعلمه إلا الله، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان على عهد النبي كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ))لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله((([36]).
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه، وأن مَن تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله)([37]).
وقد يكون لمن عليه مخالفات شرعية خبيئة حسنة أو عمل صالح قد يكون سببًا في تكفير سيئاته، فلا يجوز للعبد أن يقتحم على الناس قلوبهم ويفتِّش ما فيها، وينصّب نفسه في عملٍ من شأن الخالق وليس من شأن المخلوق الضعيف، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالأدب في التعامل معه ومع مخلوقاته، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الخاتمة:
بعد استعراض جزئيات هذا البحث وتفاصيله، فإنني أخلص إلى النتائج التالية:
1- إنَّ الجوارح أتباع وخدم وآلات، يستخدمها القلب، ويستعملها استعمال المالك للعبد، واستخدام الراعي للرعية، والصانع للآلة.
2- إنَّ العلاقة بين القلب والجسد هي علاقة تلازم وتأثير متبادل، فكلّ صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح، وكل فعلٍ يجري على الجوارح، فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب.
3- إنَّ التشريع الإسلامي قائم على العقيدة، وهذه العقيدة هي التي توجِّه السلوك وتكون أعمال الجوارح على وفقها، وكذلك فهي تعتبر بمثابة الضامن لتنفيذ أحكامه وأوامره، فقد ربطَ الإسلام تنفيذ تشريعاته بشعور المؤمن بمراقبة الله تعالى له في كل مكان وفي كل زمان.
4- لقد دلَّت النصوص الشرعية على أنَّ العبد مؤاخذٌ بأعماله القلبية كما هو مؤاخذ بأعماله الجسدية، فكلاهما محلٌّ للثواب والعقاب.
5- نحن العبيد لنا الظاهر، والله يتولَّى السرائر، فلا يطلع على ما في القلب إلا الله تعالى، ولا يجوز للعبد أن يخترق أسوار القلوب ويحكم على الناس بما فيها، فهذا من شأن الخالق وليس من شأن المخلوق الضعيف.
التوصيات:
أوصي نفسي والقرَّاء الكرام بضرورة ملاحظة أمر القلب، والاهتمام البالغ بإصلاحه بكل الوسائل المتاحة والممكنة، من خلال الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن الكريم والصحبة الصالحة والمواظبة على صلاة الجماعة والحرص على حضور مجالس العلم وغيرها من الوسائل التي تؤثِّر في استقامة القلب وصفائه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
([2]) إحياء علوم الدين (3/59).
([3]) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور ص )63( .
([4]) في ظلال القرآن لسيد قطب 2/43 .
([5]) المدخل الفقهي العام 1/69 .
([6]) الكشَّاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 2/316 .
([7]) خُلُق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص 11 .
([8]) مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور ص 367 .
([9]) في ظلال القرآن لسيد قطب 2/374 .
([10]) جامع البيان في تأويل القرآن 20/258- الدر المنثور للسيوطي 6/599- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 22/5 .
([11]) مجموع الفتاوي لابن تيمية 28/448 .
([12]) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، واللفظ له، رقم الحديث(52) 1/28 -وأخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال
وترك الشبهات، رقم الحديث (4178) 5/50 .
([13]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/167 .
([14]) مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 9/249 .
([15]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/128 .
([16]) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 8/224 .
([17]) تفسير بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي 2/197 .
([18]) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث (6708)- 8/11 .
([19]) المفهم لما أشكل في صحيح مسلم للقرطبي 14/116 .
([20]) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني 1/24 .
([21]) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي 2/107 .
([22]) إحياء علوم الدين 3/41 .
([23]) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي فضلٍ الألوسي 18/122 .
([24]) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 7/74-لباب التأويل في معالم التنزيل المسمَّى بتفسير الخازن 2/177-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
لأبي السعود 3/180- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5/253 .
([25]) أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، رقم الحديث (6672) 6/2594- وأخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط
الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم الحديث (7434) 8/169 .
([26]) إحياء علوم الدين 3/43 .
([27]) الموافقات في أصول الفقه للشاطبي 1/233 .
([28]) إحياء علوم الدين 4/384 .
([29]) الفروسية لابن القيم ص 121 .
([30]) الفوائد، لابن قيّم الجوزية، ص85 .
([31]) الفروق للإمام القرافي 1/162 .
([32]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/168 .
([33]) أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها، رقم الحديث(6566)
6/2555- وأخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم الحديث (4570) – 5/128.
([34]) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 2/267- وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/485- المغني لابن قدامة 11/401 .
([35]) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب مَن لم يٌرقَ، رقم الحديث (5752)، وأخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم الحديث (220).
([36]) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملةَ، رقم الحديث (6780).
([37]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، 12/78 .