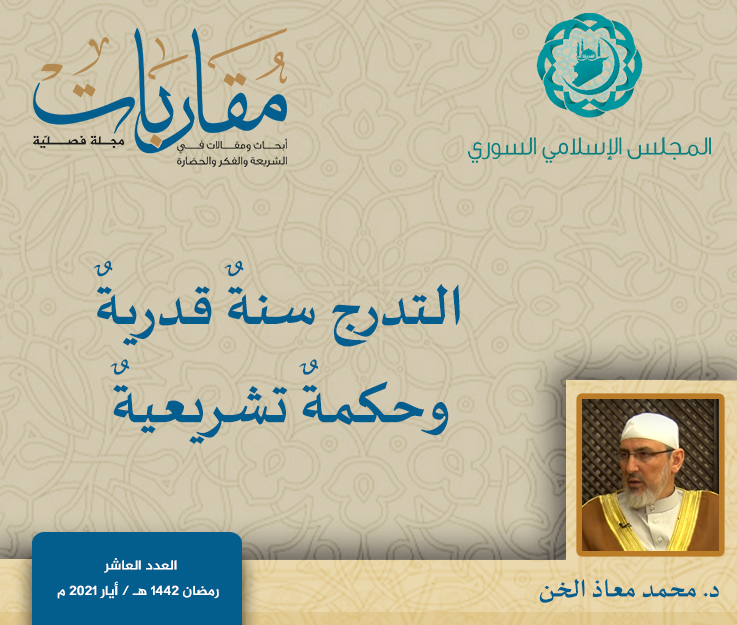أسماء الله الحسنى وأثرها في حياة الفرد وإصلاح ونهضة الأمة
مايو 10, 2021الإيمان بالغيب.. كيف يكون؟

تحميل البحث كملف PDF
محمد علي النجار – محرر مجلة مقاربات
في مطلع سورة البقرة يخبرنا ربنا سبحانه أن كتابَه القرآن سِفرٌ كامل الأوصاف جاء هداية للعباد المتقين، وإذ قد أثنى الله سبحانه على عباده المتقين بجليل من الصفات، فقد ابتدأها بذكر أخص صفاتهم ألا وهي الإيمان بالغيب، في تأكيد واضح على أن القرآن لن يكون هداية للواقفين مع عقلهم المادي فقط، متجاهلين ما انحصر به العقل البشري من إدراك الماديات والاستدلال بالمعقول على ما وراء المادة من غيب، والتأكد من صحة الأخبار وفهمها، وعدم قدرته على التدخل فيما وراء ذلك مما أثبته العقل ولم يحط به.
فالقرآن لن يكون هداية للواقفين مع المادة فقط في إنكار تام لنداء الفطرة داخل الإنسان، وإصرار لا مستند له على أن لا شيء في هذا الوجود فوق عقولهم المحدودة، أو خارج نطاق حواسهم العاجزة.
بعد أن ابتدأ القرآن بوصف المتقين بالإيمان بالغيب أكمل؛ فوصف المتقين بإقام الصلاة وإنفاق المال، فجمع لهم أطراف الدين ومقاصده؛ صحة العقيدة والقيام بحق الله وأداء حقوق الخلق، ثم عاد القرآن إلى الإيمان فثنَّى بذكره ثانية وفيه من الغيب الإيمان بما أَنزل من قبل على رسله وأنبيائه والإيمان باليوم الآخر، ليكون ما ذكر من صلاتهم وزكاتهم محفوفا بالإيمان بالغيب أولا، ثم بما يقتضيه من التصديق بكل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثانيا، قال الله تعالى: {ألم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: 1-5].
ما الغيب؟
إن العالم بالنسبة إلى الإنسان غيب أو شهادة، فعالم الشهادة كل ما يدركه الإنسان بحواسه الظاهرة أو الباطنة، وعالم الغيب كل ما غاب عن حس الإنسان أو إدراكات عقله البشري مما أخبر عنه الله ورسوله، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قال: (يؤمنون بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ وَلِقَائِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ، فَهَذَا غَيْبٌ كُلُّهُ)، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فَقَدْ آمَنَ بِالْغَيْبِ)[1]، ويدخل في الإيمان برسل الله وكتبه كل ما جاءنا عن طريقهم من أحوال البعث والقيامة وغيرها.
ولكل من عالم الغيب والشهادة وسائله المعرفية الخاصة به، فعالم الشهادة بكل ما فيه وسيلة معرفته الأصيلة الحواس والعقل والفكر، بخلاف عالم الغيب الذي لا وسيلة لمعرفته سوى الوحي، يؤكد الأستاذ محمد المبارك ذلك في حديثه عن الفرق بين عالمي الشهادة والغيب فيقول: (إن الإسلام وضع الإنسان وجها لوجه أمام الكون إذ أزال ما بينهما من حواجز كما أنه أخضعه له، لتفكيره وتجربته وتسخيره وأزال عنه وعن جميع أجزائه صفة التقديس والتأليه التي كان يتصف بها في الديانات الوثنية والعقائد الخرافية، وجعل الحواس بمعونة العقل أو العقل بمعونة الحواس طريقا للوصول إلى معرفته ومصدرا لكشف حقائقه وجعلها المرجع المختص بذلك) ولكن مقابل ذلك أخلى القرآن مسؤولية الإنسان عن عالم الغيب إذ أسند مسؤوليته إلى الوحي، يقول الأستاذ: (بخلاف عالم الغيب فقد جعل الوحي للأنبياء هو مصدر معرفته والمرجع المختص في ذلك)[2].
ولا يدخل في الغيب ما غاب عن حواسنا الخمس وأدركناه بمقدمات ونتائج رياضية مجردة، فإنك لو أعطيت طفلا مسألة حسابية ثم جاءك بحلِّها أو جوابها؛ فإن هذا لا يعني أصلا أنه يعلم الغيب لأن ما وصل إليه مدرك بمجموعة من المقدمات والنتائج العقلية، وكذلك كل ما حكم بمقدمات وأسباب ونتائج فليس بغيب كعلم الأرصاد وتوقع الأمراض والكوارث ونتائج التجارب والعلوم، فإنه ليس بغيب شرعا كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، فكل قضايا الكون التي تدرك بالعلم جزء من عالم الشهادة، فهي لا تدخل في الغيب.
ما الإيمان؟
الإيمان أن يصدق الإنسان تصديقا جازما ليس معه شك بالله وصفاته وبكل ما أخبرنا به في كتابه أو بواسطة أنبيائه، مع ما يقتضيه هذا الإيمان، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: (وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونُوا مَوْصُوفِينَ بِالْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ قَوْلًا وعملا واعتقادا)[3]، وفي الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا الإِيمَانُ؟)) قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ))[4].
لماذا الإيمان بالغيب؟
إن الإيمان بالغيب هو الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان، وبين من عَبَدَ ومن كفر وجحد، فبه يعلن الإنسان التسليم لخالقه ومولاه بالعقل الذي منحه إياه وأمره بأن يقف به حيث أوقفه، ويسلم فيما لم يأذن له به… وقد جاء الإيمان بالغيب ليفرغ الإنسان من الاشتغال بالأسئلة التي تتجاوز قدراته لينشغل بالعمل في هذه الحياة وإعمارها، وملء الوقت بالعمل المفيد المثمر. فالإيمان بالغيب يسَّر على الإنسان حياته واختصر عليه الكثير من الجهد العقلي المضني الذي قد يصل في حالات كثيرة إلى نتيجة لا تساوي شيئا سوى الضياع الذي وصل إليه كثير من الفلاسفة، الذين حاولوا بعقولهم القاصرة أن يتجاوزوا الوحي والغيب، فقضَوا وهم يتخبطون بين إثبات الألوهية ونفيها، وفي تصديق البعث أو تكذيبه، ولم توصلهم علومهم المتجردة عن اعتبار نهج الله إلى شيء.
إن الإيمان بالغيب يحجز الإنسان عن ارتكاب الكثير من المساوئ لأنه يعلم أن الله مطلع عليه في حركاته وسكناته، وأن بعد كل عمل سؤالا وجوابا ومكافأة وعقابا.
كما أن الإيمان بما أخبرنا الله به يمنح الإنسان شعورا تاما بالطمأنينة ويلهمه الصبر ويحفظه من اليأس بينما يفتقد الملحد كل ذلك.
عقلنة الغيب
إن من أكبر الفتن التي عصفت بالجيل المسلم اليوم محاولة عقلنة الغيب، لجعل كل مسألة منه في موضِع القبول أو الرد العقلي المطلق، خاصة أمور القدر والثواب والعقاب الرباني للمسلم والكافر، لتبدو قريبة إلى الحس كقرب أي مسألة رياضية أو فيزيائية نتوصل بمقدمات بسيطة إلى نتائجها القطعية.
والواقع أن محاولة تكييف الغيب وعقلنته حتى يصبح كالمشاهد قد تخرج بالمؤمن من طور الإيمان الحقيقي بالغيب، لتصل به في مرحلة لاحقة إلى أن تتعارض لديه مبادئ إيمانه العقلي المجرد بمبادئ إيمانه بالغيب، وحينها قد يقع له ما وقع لكثيرين من الشك بالله، أو تحريف كلامه وتحويره عن معناه وسياقه ليتوافق مع عقله القاصر.
وهذا ما قام به فئات من المعتزلة وغيرهم قديما عندما حاولوا الموافقة بين العقل الفلسفي بمطلقه وقواعد الدين كلها فوقعوا فيما وقعوا فيه. فلم ينتظم في فكر المعتزلة أن يعذب الله على العمل وهو قدَّره ولم ينتظم عند الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يَخلُد الكفار في نار جهنم فأنكر بقاءها وجزم بخروج أهلها منها واستدل لذلك بما ليس بدليل[5]، ولم ينتظم في عقل البعض اليوم أن يدخل الله الملاحدة نار جهنم ففسروا الإيمان والكفر بما يتناسب ومنطقهم غير السوي، ووصل الأمر بهم أن يدخلوهم جنة لم يؤمنوا بها أو بخالقها يوما، ونسوا في حمأة العقل المادي قول الله عن هؤلاء المكذبين {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [سورة الفرقان: آية 23]، ولو أنهم آمنوا بالغيب حق الإيمان فتركوا ما لم تدركه عقولهم إلى إيمانهم بعدل الله وحكمته لكان لهم وللناس في ذلك خير وفضل.
هذا وإن محاولة الكشف عن حكمة الله من بعض أحكام شرعه ليست عقلنة للغيب، وإنما محاولة للبحث في حكمة الله وعمل على تثبيت الإيمان في القلوب. كما أن البحث في الحكمة ليس تعليلا للأحكام أيضا؛ بحيث إن انتفت الحكمة انتفى الحكم وإن وجدت وجد! فالقول بأن العلة في تحريم الخمر منع العقل من الضياع تفضي بالبعض إلى اعتقاد أنه حلال إن لم يؤثر على العقل، وتعليل وجوب العدة بإبراء الرحم فقط – كما يقول البعض – يفضي بهم وفق منطق العقل المجرد إلى نفي العدة عن المرأة التي لا تلد أو الاكتفاء بحيضة واحدة، والحق أن العلة في تحريم الخمر وإيجاب العدة التعبد بأمر الله وإيماننا بالغيب الذي يفضي بنا إلى قبول أحكامه، وما يذكر بعد ذلك هو من قبيل التفتيش عن حِكَم الله في تشريعه لتثبيت الإيمان واستنباط مزيد من الأحكام وفق قواعد القياس لا من باب التعليل لها، لأن العلة فيها هو الإيمان وما يستوجبه من خضوع للإله الحكيم، وتعبد بأوامره.
وهنا أمر لا يمكننا تجاوزه بحال إن لم ننبه عليه؛ إن إيغال بعض الدعاة المعاصرين في تعليل الأحكام وأوامر الله، أو التمحل في إثبات الإعجاز العلمي والمادي في القرآن والسنة؛ مع عدم التركيز على مسألة الإيمان وعلة التعبد في الأحكام أوصل بعض الناس في مرحلة من المراحل إلى شيء من الضياع، أو التخلي عن إيمانهم بعد أن انتهبتهم الشكوك. وإن لهذا الأسلوب العقلي المفرط في شرح الإيمان، أو ترتيب السعادة الدنيوية على الإيمان والطاعة، والشقاء الدنيوي على الكفر والمعصية، أثرا كبيرا في ظهور الجيل الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [سورة الحج: الآية 11].
كما كان لبعض الحداثيين المتأثرين بالقيم الغربية والمنطقية المادية أكبر الأثر في انتشار الشك بالغيب، إذ حرفوا كلام الله وأدخلوا اليهود والنصارى والملاحدة جنة الله – طالما أنهم لم يؤذوا أحدا – بزعم أن ما يفهم من خلود الكفار في نار جهنم يتعارض مع مبادئ الرحمة والغفران التي يتمتع بها أصحاب الإنسانية السوية فضلا عن الرب الرحيم، ناسفين بذلك كل ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الحديث عن هذه القضية المفصلية في شرع الله، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟) فَقَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ))[6].
وإن هؤلاء الذين يساوون بين المؤمن والكافر وبين من رضي عنه الله وسخط عليه؛ هم أول من أصيب في إيمانه بدَخَنٍ، فلا أدري كيف يهدون غيرهم إذ لم يهتدوا حق الهداية، قال ربنا سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 40-42]، ليت شعري إن لم يدخل في هذه الآيات؛ المتشككون بأحكام الله الظاهرة البينة فمن يدخل فيها!؟
مختصر الأمر أن الكِبر والاعتداد بالعقل في مقابل الإيمان بالوحي هو السبب الأساس في الجدال في غيب الله وإنكار قَدَرِه، أو تأويل عدلِه.
لماذا يدخل الشك في إيمان الناس:
إن من أول ما يشك به المؤمنون – إيمانا تقليديا – في المصائب هو الإيمان، إذ إنهم يعتادون النعمة والرب المنعم، فإن جاءهم الابتلاء لجؤوا إليه بفطرتهم أو بمقتضى ما نشؤوا عليه من إيمان تقليدي؛ فإن تأخرت عنهم الإجابة التي يريدونها وبالشكل الذي طلبوه انقلب دعاؤهم سخطًا وشكًّا، وما أكثر هذا النوع من الشاكين والملحدين في مناطق الحروب والصراعات!
والقسم الثاني من الناس يدخله الشك من مجالسة أهل الشك والاستماع إليهم، فإنه يحصل له بمجالستهم من الوساوس والشكوك مثل ما عندهم ولهذا أمرنا ربنا بالبعد عن الخائضين في آياته فقال: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]، وفي مقابل ذلك أَمرَنا بصحبة الصادقين ومجالستهم فقال لنا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].
كما أن للمعاصي وما تحمله من ظلمات دورا كبيرا في إيقاع الناس في الشكوك، وإخراج الإيمان من دائرة اليقين القلبي ليعود إلى مرحلة الشك والأخذ والرد.
مراتب الناس في التعامل مع الغيب:
إن الناس في نظرتهم إلى الغيب أصناف ثلاثة:
الأول: صنف لا يقبله لأنه لا يدركه بحواسه وقدراته العقلية وعليه الملاحدة وكثير من الفلاسفة.
الثاني: صنف موغل في الغيب لا ينفك في حكمه على الحياة عنه، إن رأى اختلاف أحوال الدنيا وتقلبها وتنوع أحوال الخلق نسب كل ذلك إلى الغيب الذي لا يمكن تغييره، وتقاعس عن العمل والسعي في الأسباب لأن الأمور حسب اعتقاده مقدرة لا تحتاج إلى عمل، في فهم مقلوب لقضايا الغيب والقضاء والقدر التي جاء بها الإسلام، يقول الأستاذ محمد المبارك متحدثا عن انقلاب المفاهيم العقدية عند جمع من المسلمين: (لقد كانت عقيدة القضاء والقدر فلسفة إقدام في الحياة ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له))، فليس إقدامك على الجهاد ولا دخولك المعركة بقاتل لك إذا لم يأت أجلك. فلا تخف لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك فلن يصيبك ضرر إذا لم يرد الله ذلك. فإذا بهذه العقيدة نفسها تصبح فلسفة تواكل وإحجام: لا تعمل فرزقك يأتيك، ولا تجاهد لأن الله ينصرك إذا أراد من غير جهاد ولا حرب)[7].
الثالث: وأما الصنف الثالث فهو صنف من الخلق آمن بالغيب والقضاء والقدر وبكل ما أخبر عنه ربنا سبحانه، وقد كان إيمانه بغيب الله وقدره دافعا له للعمل بما أمره الله به، والأخذ بأسباب السعادة الدينية والدنيوية والبعد عن مواطن الشقاء، فتفكر في خلق الله وآمن بخالقه، وآمن بمقادير الله وأخذ بأسباب التقدم والرقي الحضاري، وتعلم العلوم وقوانين الفيزياء والكيمياء وطبائع المخلوقات وعلم أن ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الصنف من الناس هو الذي قصد الإسلام إلى تربيته، واعتنى الشرع بتنشئته، جيل يفهم عن الله، ولا يهمل دنياه أو أخراه.
لا ملجأ لنا إلا الإيمان بالغيب:
إن الإيمان بالغيب لا يعني أبدا أن الإسلام دين خرافة! إن الإسلام متوافق تماما مع الفطرة السوية والمنطق السليم، بل إن القرآن الكريم هو الذي علم البشرية الفصل بين قوانين عالم الشهادة وقضايا عالم الغيب، فلم يفسر ظاهرة طبيعية ذكرها تفسيرا غيبيا أو خرافيا كما كان يعتقد وثنيو العالم القديم أو فلاسفة اليونان، من أثر لحرب الآلهة على الكون وحياة البشر، أو تأثير لذهاب الطير يمينا أو شمالا في نجاح المقصد أو فشله، أو أن للكواكب قدرة على تغيير قدر الناس، وللجن وعالم الأرواح مثل ذلك الأثر في حياة البشر، بل ويعتقدون في بعض ملوكهم أنهم من نسل الآلهة المقدسة التي تزوجت ببعض البشر حلالا أو حراما فكان لها فيهم نسل وذرية.
لقد رفض القرآن كل تلك الخرافات ورفض نسبة ظواهر عالم الشهادة إلى أسباب غيبية، وفسر قضايا الكون ومظاهر الطبيعة وسنن الحياة تفسيرا طبيعيا تدركه الحواس والعقول والأفكار، ثم نسب كل ذلك إلى قدرة الله الخالق الذي خلق فأبدع، وقدَّر فأحكمَ، واختص بعلم الغيب فلا يُطلع عليه إلا من ارتضى، ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 26-27].
إن الإسلام دين الفطرة والعقل، والإيمان بعالمي الشهادة والغيب والإله الخالق لهما والقادر عليهما جزء من الفطرة السليمة والعقل السوي، والإنسان الحق من يستمع قول الحق وهو يناديه: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
أما ما نراه اليوم من الشبهات فمرده فساد الفطرة وتقلب الأوضاع، التي لا تخرج الإنسان من شك حتى توقعه في آخر، ولا يعصمه من هذا إلا إيمانه بالله وبغيبه الذي يستطيع الإنسان أن يستدل عليه بعقله، ولكنه لا يتمكن من الإحاطة به، وإن المؤمن إذا أدام تقوية إيمانه بالتفكر والعبادة وصحبة الصادقين مَنَّ الله عليه برتبة اليقين، وهي الحالة التي لا يكون معها إيمان العبد قابلا للأخذ والرد، فيفتح الله على بصيرته حتى تغدو أمور الغيب عنده أقرب إلى العيان ببصيرة القلب لا بمنطق الفكر، قال ربنا سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75].
[1] : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/36).
[2] الإسلام والفكر العلمي (117)
[3] تفسير الطبري (1/235).
[4] صحيح البخاري، رقم (50)، وصحيح مسلم، رقم (5).
[5] من كلامه رحمه الله في ذلك: (وفي المسند للطبراني: ذكر فيه “أنه ينبت فيها الجرجير”، وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب، ولا سنة ولا أقوال الصحابة)، انظر رسالته “الرد على من قال بفناء الجنة والنار” (67).
قال الشيخ الألباني في وصفه ما ذهب إليه الإمامان ابن تيمية وابن القيم: (حتى ليبدو للباحث المتجرد المنصف أنهما قد سقطا فيما ينكرانه على أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحة وحملها على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم، حتى بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه كما يفعل). وقد اعتذر لهما فقال: (فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه ابن قيم الجوزية؟ فأقول: إن أحسن ما أجد في نفسي من الجواب عنهما إنما هو أنه لما توهما أن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك وهم قدوتنا جميعا – لو صح ذلك عنهم رواية ودراية ولم يصح كما سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعاني رَحِمَهُ اللَّهُ – واقترن مع ذلك غلبة الخوف عليهما من الله {ولمن خاف مقام ربه جنتان}، والشفقة على عباده تعالى من عذابه، وغمرهما الشعور بسعة رحمته وشمولها حتى للكفار منهم، وساعدهما على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها؛ فأذهلهما ذلك عن تلك الدلالة القاطعة وقالا ما لم يقل أحد قبلهما، وما أرى لهما شبها في هذا إلا ذلك المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربه فلا يقدر على تعذيبه. انظر مقدمة “رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار”، ص (21-22).
[6] صحيح مسلم، رقم (151).
[7] الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية (37 و38).